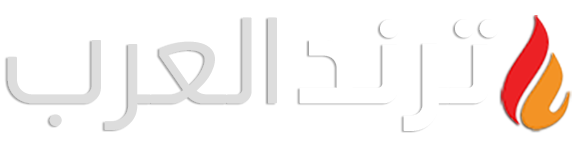جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
اعتمدت في الورقة البحثية التي شاركت بها في المؤتمر الأول للسينما العربية – الذي نظمته نقابة السينمائيين بالإسكندرية وجاء تحت عنوان الإنتاج السينمائي العربي المشترك الواقع وآفاق المستقبل – على طرح ثلاثة محاور أساسية.
المحور الأول: لماذا نحتاج إلى الإنتاج السينمائي المشترك؟ بمعنى آخر؛ ما أهمية تلك التجربة ومردودها؟
بينما تمثل المحور الثاني في طرح العقبات والتحديات ومن بينها الخضوع لكراس الشروط الضمني؟
أما المحور الثالث فتحدثت خلاله عن كيف نُسهل عملية الإنتاج المشترك ونذلل العقبات التي تُعطله؟
أولاً: لماذا نحتاج إلى الإنتاج السينمائي المشترك؟ أهميته؟
عندما شاركت في لجنة التحكيم بمهرجان موسكو السينمائي الدولي أكتوبر ٢٠٢٠، أول شيء فعلته عندما أصبح قاعدة البيانات بالدورة مكتملة أنني بحثت عن المشاركة المصرية والعربية، لأنقل صورة للقارئ العربي. لكني لم أجد لمصر أي مشاركة، باستثناء التحكيم.
لكن صباح يوم الختام وإعلان الجوائز فُوجئت باتصال من المركز الصحفي يسألونني إن كنت أوافق على الصعود للمسرح لتلقي جائزة الفيلم المصري «ستاشر» للمخرج سامح علاء الذي فاز بجائزة أحسن فيلم قصير رغم تميز الأفلام القصيرة الأخرى، مما يعني المنافسة الشرسة، وهذا ما أكدته رئيسة لجنة التحكيم قبل تسليمي الجائزة.
في تجربة موسكو، ومن خلال تواصلي مع صناع الفيلم الذين لم يكن لديهم أدني سابق معرفة بمشاركة الفيلم في المهرجان، واكتشفت أن المنتج الفرنسي المشارك هو الذي تقدم بالفيلم للمشاركة في المسابقة، وربما لذلك كان الفيلم مُسجلاً بأنه فرنسي.
بعد ذلك بحوالي ستة أشهر فقط ثم إعلان فوز الفيلم ذاته في مهرجان كان السينمائي كأحسن فيلم قصير.
هذه التجربة مؤكد تحمل دلالة. أن الإنتاج المشترك يفتح الأبواب أمام أفلامنا للمشاركة ي المهرجانات الدولية ويُتيح لها المنافسة على الجوائز وربما الفوز بها.
تجربة أخرى لها دلالتها
المخرج المصري عمر الزهيري الذي حصد فيلمه جائزتين من مهرجان كان السينمائي ٢٠٢١، كنت أجريت معه حواراً أثناء حضوري فعاليات مهرجان كارلوفي فاري الخامس والخمسين، فأخبرني أن فيلمه «ريش» إن كانت خطة توزيعه في مصر لا يُتوقع من وراءها الكثير، لكنه سُيعرض في خمسين دار عرض فرنسية؟ طبعاً سيكون هناك تفكير في أسواق أخرى أوروبية لأن المنتجة الفرنسية تريد استعادة إيرادات الإنتاج، ولأنها أيضاً متميزة في مجالها.
سأتحدث بعيداً عن الجوائز.. فالأهم بالنسبة لي المشاركة في مسابقة مهمة في مهرجان مثل كان أو كارلوفي فاري. لذلك أتساءل: لو كان الفيلم إنتاج مصري خالص هل كان نجح أن يدخل المسابقة؟ هل كان صناعه قادرون على عرضه في خمسين دار عرض؟ احتمال. لكنه احتمال غير مؤكد، بل ضعيف.. المؤكد أن وجود منتج فرنسي معروف، وله مصداقية وشبكة علاقات قوية في السوق الفرنسي والأوروبي يُسهل دخول أفلام تحمل اسمه في المسابقات وبيفتح الأسواق الفرنسية أمام الفيلم المصري.
نماذج أخرى من تونس
فيلم «نحبك هادي» .. مثلاً، في عام ٢٠١٦ شارك في المسابقة الرسمية لبرلين.. بعد غياب السينما العربية ٣٧ سنة عن هذه المسابقة. كان آخر هو فيلم «إسكندرية ليه..» ١٩٧٩ الذي فاز بالدب الفضي.
هنا، عندي سؤال: هل السينما المصرية بكل تجارب شاهين، والمخرجين الذين تخرجوا من مدرسته – مثل يسري نصرالله، عاطف حتاتة، وأسماء البكري – لم يكن بين أعمالهم ما يستحق المشاركة في المسابقة الرسمية في مهرجان برلين؟
هل المخرجين المصريين الآخرين خارج مدرسة شاهين – مثل مجدي أحمد علي، صلاح أبو سيف، علي بدرخان، وعاطف الطيب، وداود عبد السيد، ومحمد خان، وخيري بشارة لم يكن بين أعمالهم ما يستحق العرض في مسابقة مهرجان برلين؟!
هل المخرجين العرب الآخرين لم يقدموا ما يستحق العرض في مسابقة مهرجان برلين طول ٣٧ عاماَ.
هل لم تنتج السينما المصرية والعربية فيلماً يستحق أن يشارك في مسابقة مهرجان برلين ؟؟
أكيد طبعاً كان هناك أفلام قوية فالسينما المصرية والعربية ولادة. إذن، لماذا لم يشارك أياً منها؟! هذه قضية من الممكن دراستها ومعرفة أوجه التقصير هل بسبب السينمائيين المصرين والعرب؟ أم بسبب المنظمين لمهرجان برلين؟
لكن المهم، كيف استطاعت تونس أن تدخل المسابقة الدولية في برلين عام ٢٠١٦؟ إن كلمة السر تكمن في الأخوين داردين، ثم في الثورة التونسية التي كانت وقتها ملهمة للعالم. فإذا تأملنا منظومة الإنتاج بالفيلم سنجد منتجة ثقيلة الوزن الفني والسينمائي ولها تاريخ قوي هي درة بوشوشة.
الحقيقة المؤكدة أن درة بوشوشة علاقتها جيدة بالغرب، وبمنظومة الإنتاج هناك. لقد نجحت أن تُقنع أثنين من أهم المخرجين المنتجين في العالم هما الأخوين داردين – الحاصلين على سعفتين من كان – والمؤكد أن أي مهرجان في الدنيا يفتخر أن اسمهما يكون في مسابقته سواء إنتاجيا أو إخراجياً، فيأخذون أفلامهما حتى لو كانت متوسطة القيمة – بسبب اسمهما وتاريخهما الطويل، وحصة كبيرة من الجوائز فهناك اثنين سعفة ذهبية وغيرها من الجوائز المرموقة دولياً، كما أنهما من أقطاب سينما اليسار.
والدليل علي ما أقول أنه في نفس السنة التي شارك فيها فيلم «نحبك هادي» في برلين، وهما منتجين مشاركين فيه، كان لهما فيلم من إخراجهما في مسابقة مهرجان اسمه «الفتاة المجهولة». الحقيقة أنني شاهدته وقت عرضه في كان وأصبني بإحباط شديد، لأنه فيلم سطحي جدا لأبعد الحدود. وكنت مندهشة جدا وتساءلت كيف بعد تاريخهما الطويل يصنعا فيلما خاوياً وسطحياً لهذه الدرجة، والأهم كيف ولماذا يقبله مهرجان عريق مثل كان؟؟
ما سبق يقودنا لنقطة أريد توضيحها؛ أن فيلم «نحبك هادي» صحيح أنه فيلم جيد، لكنه لم يكن عملاً عظيما أو فتحاً في السينما العربية، لكن تصادف مع عرضه توفر مجموعة من الظروف؛ منها الثورة التونسية التي كان مرحب بها في العالم أجمع، إلي جانب وجود اسم الأخوين دراردين في الإنتاج. لذلك حصد جائزتين، واحدة منهما كانت مقبولة لأنها أفضل عمل أول، لكن الجائزة الثانية في التمثيل لمجد مستورة كانت مجاملة وكان هذا واضحاً للجميع، خصوصا في ظل تواجد نجوم أقويا في عالم فن الأداء بتلك المسابقة آنذاك.
الرجل الذي باع ظهره
نموذج سينمائي آخر يكشف مزايا الإنتاج المشترك التي تعد بلا حدود، والتي تفتح الأبواب المغلقة على مصراعيها، والتي تسهل الطريق وتُعبده أمام الترشح للأوسكار والوصول إلى القائمة القصيرة وإن خرج من دون اقتناصها في الختام.
هذا النموذج الذي أقصده هو فيلم «الرجل الذي باع ظهره».. شخصياً أراه فيلماً جيداً، لكنه ليس عظيما، وهناك أفلام عربية أنتجت في نفس العام أكثر أهمية منه، لكنه تميز عليها إنتاجياً في أن ما يقرب من عشرين جهة منحته دعما فصار إنتاجاً مشتركاً متعدد الجهات،
لكن يظل التساؤل؛ لماذا يُعد فيلما جيدا مرحب به إلي حد أن يحصل علي كل هذا الدعم الأوروبي، إنها التيمة والأفكار المطروحة بداخل الفيلم والتي تغسل يدين أوروبا وتطهرها من دماء المهاجرين غير الشرعيين. والوجه الحسن المتعاطف. إنها السياسة مجددا.
وهذا كله يُفسر لماذا أُتيح للفيلم الفرص الثمينة للعرض في دول ومهرجانات ومسابقات عدة، وهذا بدوره ساهم في الترويج له، كذلك القصة المقتبسة عن لوحة عالمية، وإشراك نجوم عالميين. فهذه كلها أمور لا يمكن أن نغفل أهميتها في الترويج للفيلم والمكانة التي وصل إليها، حيث الترشح لأوسكار أفضل فيلم أجنبي والوصول للقائمة القصيرة، وإن فاز بالجائزة عن جدارة الفيلم الدانماركي السويدي الهولندي المشترك «جولة أخرى» للمخرج المرموق توماس فينتربيرج.
من هنا، حتى وإن تحفظت على بعض تيمات وأفكار أفلام الإنتاج المشترك، لكن لابد من الاعتراف بأهمية أن يكون لنا شراكات أجنبية مع الغرب. فلاشك أن الشراكة الإنتاجية تعمل على تحريك الأمور الفنية والسينمائية والإبداعية، وتدفع بها نحو الأمام، تفتح نوافذاً جديدة على العالم من خلال الاشتراك في المهرجانات السينمائية الدولية وربما نيل بعض جوائزها، وكذلك إتاحة الفرصة للعرض في السوق الدولي.
إذن، الإنتاج السينمائي المشترك وسيلة فعالة للخروج بالفيلم من سوقه المحلي المحدود وتوسيع دائرته في السوق العالمي. إنه قناة اتصال وتواصل مع العالم، وجسر متين يجتازه الشركاء سوياً لو شيدوه على أسس فنية وتجارية دقيقة.
من زاوية أخرى، تُسهل الشراكة الإنتاجية السينمائية تصوير أفلام كل طرف على أرض الطرف الآخر، تُذلل العقبات وتمنح كافة التسهيلات اللازمة والإجراءات الممكنة كإعفاء الأفلام المشتركة من الضرائب، أو تلك التي تضمن فتح سوق كل طرف أمام أفلام الطرف الآخر.
أما باقي المحاور لورقتي البحثية فأطرحها في مقالي القادم.