لا يكاد يمر يوم دون أنباء عن أحداث أو توترات داخلية في هذه المدينة أو تلك، أو انفجار أزمة هنا وأخرى هناك، كما لا تكاد تلمس ما يمكن أن يُطمئن قلوب وعقول الناس بإمكانية معالجة جدية لما يتعرض له النسيج الاجتماعي من أعطاب، أو بلورة رؤية وأدوات قادرة على تحسين أو تغيير أحوال العباد والبلاد. والملفت أن حالة التفكك الداخلي لم تعد تقتصر على حالة الانقسام بين السلطة وحركة حماس، والتي للأسف تنزلق يوميًا نحو حالة انفصال جغرافي وسياسي وإداري لكيانين تتسع الهوة وحالة الشقاق بينهما، وكأن لا عودة عن هذا الحال.
هذا يجري بصورة متسارعة تجعل من حالة الإحباط وكأنها تهيمن على حياة الناس وعلاقاتهم اليومية، في وقت لا يخلو فيه بيان يصدر عن أي جهة رسمية أو حزبية من الأطراف المهيمنة على المشهد العام إلا ويكرر عبارات باتت ممجوجة ومنفصلة تمامًا عن واقع الممارسة بإدّعاء الحرص على استعادة وتمتين الوحدة الوطنية، ومشددًا في الوقت ذاته على أن حكومة الاحتلال هي المستفيد الوحيد من هذا الانقسام والتفكك في الأوضاع الفلسطينية، رغم مرور ما يزيد عن خمسة عشر عامًا من الانقسام، وهم يكررون هذه العبارات التي لا تحصد سوى المزيد من خيبة آمال الناس، بينما تواصل اسرائيل حصارها لقطاع غزة وتحويله لسجن كبير، تزداد فيه معدلات الفقر والبطالة ورغبة الشباب في الهجرة بمعدلات عالية، بل وغير مسبوقة، بينما تستمر حكومة الأمر الواقع لحركة حماس في فشلها وعجزها عن إيجاد حلول لمعضلات حياة الناس سوى فتات تسهيلات اسرائيلية أو تسول أموال قطرية، وفي نفس الوقت تطلق اسرائيل يد قوات جيشها ومستوطنيها للتنكيل بالأبرياء، ونهب المزيد من الأرض ومصادر الرزق، كما تواصل سياسات هدم البيوت والتوسع الاستيطاني في كل بقعة من أراضي الضفة الغربية، سيما في القدس المحتلة التي يواجه أهلها عملية تطهير عرقي معلنة ورسمية، دون أن تكترث اسرائيل للمواقف الدولية وهيئات حقوق الإنسان التي بدأت تصنفها كدولة تمييز عنصري ضد الفلسطينيين سواء في الأرض المحتلة منذ عام 1948 أو التي تحتلها منذ حرب حزيران 1967، بينما تغرق السلطة في حالة عجز متفاقمة تحول دون قدرتها على الاستجابة للحد الأدنى من احتياجات الناس وصون حياتهم وكرامتهم من الانتهاكات الخطيرة التي يتعرضون لها. الأمر الذي يجعل الحديث عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 مجرد وهم وتمرين ذهني مكرر وشعار يرفض أصحابه ممارسة ولو الحد الأدنى من إعمال العقل، ومحاولة الخروج من حالة الجمود الفكري والسياسي المزمنين التي باتوا أسرى لتبعاتها، سيما في ظل حالة الإجماع التي تتعمق في المؤسسة الاسرائيلية الحاكمة ضد إقامة دولة فلسطينية.
لا يحتاج من يُدقق في أوضاع الحركة الوطنية لجهد كبير ليخرج باستخلاص جوهري، بأن حالة التفكك في بنيتها ناجمة بصورة أساسية عن غياب مشروع وطني جامع، وإصرار النُخب الحاكمة على تغييب وتهميش دور الناس والقطاعات الشعبية ،ومصادرة دور المؤسسات الوطنية التي من المفترض أن تشكل الخيمة الجامعة والقادرة على بلورة توجهات عمل موحدة وملموسة لمواجهة التحديات الهائلة التي تعصف بمستقبل القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا الوطنية.
إذا كانت قيادات قوى الانقسام نفسها تردد دومًا أن الانقسام وتهميش دور منظمة التحرير ومؤسساتها، يوفران فرصة تاريخية للمشروع الاستعماري الاسرائيلي، ويفتح شهية حكومة الاحتلال لمواصلة مخططاتها التصفوية، أليس من حق الناس في مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني أن تسأل هذه القيادات عن مسؤوليتها المباشرة، ليس فقط عن تدهور ظروف حياتها المعيشية الناجمة عن سياسات الاحتلال أو تلك التي يولدها الانقسام، من ناحية، وغياب دور المؤسسات الوطنية في الدفاع عن مصالح هذه التجمعات، من ناحية أخرى، وكذلك عن مسؤوليتها في تفشّي ظواهر الفساد والمحسوبية وغياب الحد الأدنى من العدالة سواء في توزيع الثروة أو أعباء مواجهة الاحتلال، بل، وعن تحملهم أيضًا للمسؤولية عما يتعرض له مستقبل القضية الفلسطينية من مخاطر حقيقية تكاد تفتك بحقوق شعبنا المشروعة وتطيح بكل تضحياته وإنجازاته على مدار ما يزيد عن قرن من النضال المتواصل.
إدارة ظهر القوى المهيمنة على المشهد لهذه الحقائق والأسئلة المشروعة التي تعتمل في عقول وضمير الأغلبية الساحقة من الناس، الذين يدفعون ثمن هذا التدهور في كل مناحي حياتهم، والشعور بالعزلة وحالة تفكك الترابط التي يعيشها كل تجمع فلسطيني وتباين معضلاتها وقضاياها عن التجمع الآخر وكأنها باتت جزرًا معزولة كل منها عن الآخر، الأمر الذي، ولشديد الأسف، لا يغيّب فقط المشروع الوطني الجامع، بل وبات أيضًا يشوّش محتوى الهوية الوطنية الجامعة. في وقت تتخندق فيه قوى الانقسام وتحشد أقصى ما لديها للحفاظ على ما توفره سلطتها من مصالح شخصية وفئوية على حساب المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.
هذا الواقع لا يمكن أن يستمر طويلًا، فحتمية التغيير قادمة لا محالة، والسؤال الوحيد هو كيف ومتى؟ وليس هناك سوى خيارين لا ثالث لهما للخروج من هذا المأزق، أولهما، ويبدو أن الزمن لا يعمل لصالحه، وهو يقوم على أساس توافق جميع القوى السياسية دون استثناء القوى الاجتماعية الفاعلة على خارطة طريق جوهرها الشراكة الوطنية في تحمل مسؤولية مواجهة الأعباء والمخاطر من خلال عقد مجلس وطني توحيدي جديد يضمن مشاركة الجميع في هيئات صنع القرار الوطني بعيدًا عن المحاصصات الانقسامية، وبحضور قوى المجتمع الحية وتجمعات الشتات، وكذلك تحمل مسؤولية مشتركة لأعباء الحكم وتوفير مقومات الصمود من خلال حكومة وحدة انتقالية تفكفك ملفات الانقسام العالقة وتبدأ بمعالجة موحدة تدريجية لها، وتعمل بجدية لتوفير مناخات وفضاءات للعمل السياسي تمهيدًا لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة وشفافة ومتزامنة للرئاسة وللمجلسين الوطني والنيابي، هذا الخيار للأسف رغم أنه الأكثر واقعية وعقلانية إلا أن فرصه تتضاءل بفعل حالة الفرز والاستقطاب الانقسامية المهيمنة، إلا أنه ما زال في متناول اليد ويحتاج لإرادة سياسية جادة وقوى شعبية واجتماعية ضاغطة للأخذ به، وإلا فإن خيار الانفجار الشعبي غير المحسوب العواقب سيكون الخيار الوحيد المتاح للناس التي لم تعد تحتمل الألم والمعاناة وحالة التيه والخطر ليس فقط على الحقوق بل وعلى مجرد البقاء. في ظل غياب قوى شعبية منظمة تمهد الطريق لبلورة تيار وطني ديمقراطي يقدم البديل الجامع، وهذا كما يبدو غير مرئي في المدى المنظور، فإن مثل هذا الانفجار قد يؤدي إلى الفوضى التي ربما لا تسمح بها اسرائيل سوى بالقدر الذي يخدم استراتيجيتها، ويمكّنها من فك وتركيب بنى المجتمع وفقًا لمصالحها الاستراتيجية، كما لن يسمح الإقليم بهذه الفوضى.
في ظل التطورات الدولية المتسارعة لتوليد نظام عالمي جديد ينهي مرحلة القطبية الأحادية والمخاض الصعب الذي يصاحبها، وربما بما يشمل تسويات دولية وإقليمية فارقة، فإن الأنظمة السياسية التي تتصرف بمسؤولية في الدول التي تحترم مصالحها ومصالح شعوبها تلجأ إلى الوحدة وتشكيل حكومات وطنية. كما أن هذا يأتي في وقت ينظر فيه المواطن الفلسطيني لحكومة الاحتلال الراهنة التي وضعت جانبًا أيديولوجياتها وبرامجها السياسية والاجتماعية ليس لحماية خطر وجودي يهدد كيانهم، بل لحماية “ديمقراطية هذا الكيان” من “النتانياهوية” التي حاولت احتواء مركبات وأسس النظام الديمقراطي في اسرائيل؛ فما بالك والحال هنا في فلسطين حيث يعاني شعبنا من احتلال وانقسام وقضم يومي للأرض والحقوق والأمل، فإنه بالتأكيد أحوج ما يكون لمثل هذه الوحدة لإعلاء شأن المصالح الوطنية، دون مجازفات أو مغامرات حمقاء قد تؤدي لتصفية حقوق شعبنا والأخطر أنها قد تدفع شهية المحتل لاستكمال ما لم ينجزه في نكبة 1948.
أمام كل هذه المعطيات، يبقى السؤال الوحيد والأخير وهو ألا يوجد في هذا البلد الجريح عقلاء ذوي مصداقية شعبية ليتقدموا بصوت العقل والانحياز للمصالح الوطنية العليا،برؤية تعيد بناء الحالة الشعبية ومؤسسات الوطنية الجامعة، وتضمن توفير كل الإمكانيات واستنهاض جميع الطاقات لتعزيز الصمود السياسي والميداني، لعلّنا ننجو من هذا المنعطف الأخطر منذ النكبة، ونفتح الأبواب نحو انتزاع حق شعبنا الطبيعي في تقرير مصيره إلى جانب مصاف الشعوب الأخرى المحبة للعدل والسلام ومبادئ الحرية والتقدم والمساواة .
من عقلاء في هذا البلد الجريح؟! جمال زقوت
ما رأيك؟
رائع0
لم يعجبني0
اعجبني0
غير راضي0
غير جيد0
لم افهم0
لا اهتم0

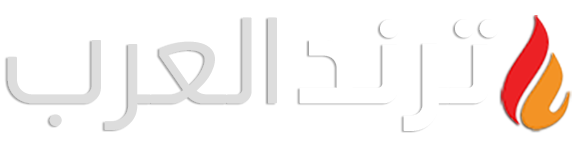




























هل لديك سؤال؟
تابعنا على السوشيال ميديا او اتصل بنا وسوف نرد على تساؤلاتك في اقرب وقت ممكن.