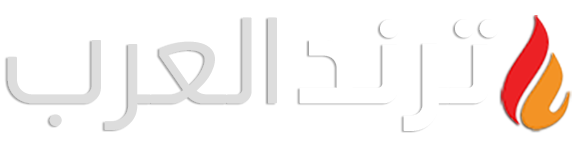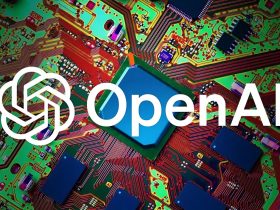في مسيرة التطور الإنساني احتاجت التغييرات الكبرى لأحداثٍ كبرى، وغالبا ما اقترنت بالعنف؛ فالتغيير المجتمعي إما أن يحدث ببطء وبشكل متدرج، وهنا نجد الدور الأساسي يقع على عاتق المثقفين والأدباء والمفكرين، والذين يدفعون أثمانا باهظة، قد تكون حيواتهم، فبينما يناضلون لتطوير مجتمعاتهم يصبحون ضحايا تلك المجتمعات، وضحايا تحريض القوى الرجعية والتقليدية، واستجابة الغوغاء لتحريضهم.
وإما أن يحدث التغيير المجتمعي بنقلة نوعية تحدثها السلطة وأدواتها، أي عندما تتولى السلطة قوى تقدمية وثورية، ولكن ما يحدث فعليا هو تراجع تلك القوى المسيطرة عن شعاراتها بعد تنعمها بخيرات السلطة، وتصبح الحاجة لقوى ثورية جديدة تناضل ضدها.. وهكذا.
في الحالة الفلسطينية ولأن الشعب قابع تحت الاحتلال، شكلت الثورة الفلسطينية المسلحة أحد أهم وأبرز أشكال التغيير المجتمعي في مرحلة ما بعد النكبة، وحتى قيام السلطة الوطنية.. ولكن معضلة “التحرر الوطني، والتحرر المجتمعي” ظلت قائمة، خاصة فيما يتعلق بأيهما أولى وأسبق..
في الأرض المحتلة، حدث التغيير الأبرز خلال الانتفاضة الشعبية (1987) والتي كانت شكلا متقدما وناضجا من المقاومة الشعبية. وعند دراسة تلك التجربة الرائدة، سنجد أنها أحدثت تغييرات إيجابية مهمة، فمثلا نحّت القوى العشائرية جانبا، وعملت على تفكيك النظام الأبوي التقليدي، وأعادت ترتيب العلاقة بين المرأة والرجل وبين الأب والأبناء، ومنحت مساحة أوسع للمرأة لتتحرك ضمنها، وأوجدت ما يمكن تسميته ديمقراطية شعبية (لجان الانتفاضة)، وخلقت نوعا من المساواة المجتمعية حيث حيدت القوى الاقتصادية والدينية المسيطرة، وفرضت قوى جديدة مثلتها المجموعات الشبابية وفصائل العمل الوطني.
إلا أنها في الوقت ذاته، وبدءا من العام الثاني للانتفاضة، شكلت نكوصا عما كان متحققا من حياة مدنية وفكرية مستنيرة، فبعض اللجان الشعبية (خاصة المحسوبة على التيارات الإسلامية، وحتى من فتح) فرضت بطرق عديدة على المرأة أن تلتزم بالحجاب، وقيدت حركتها، وفرضت على المجتمع مجموعة من القيم المستمدة من أيديولوجيات الإسلام السياسي والفكر السلفي المحافظ، مثل حظر الاختلاط، ومنع كل أشكال الفرح والاحتفال بالحياة (أعراس، حفلات عامة، حتى حفلات عيد الميلاد)، ثم تحولت تلك “الديمقراطية الشعبية” إلى شكل آخر من الاستبداد، ما أشاع نوعا من الفوضى، والانحراف عن الهدف المركزي المتمثل بمقاومة الاحتلال، بخلق أهداف مركزية أخرى وجعلها في المرتبة الأولى مثل التصدي لظاهرة العملاء. حيث صار بوسع أي لجنة شعبية، أو أي ناشط ملاحقة أي شخص واتهامه بالعمالة، ومن هذا المدخل تمت عودة العشائرية والتعصب القبلي والمناطقي من جديد، وبشكل عنيف، فتحتَ حجة مطاردة العملاء تمت تصفية أناس أبرياء بدوافع ثأر قبلي، أو لأحقاد شخصية.. فضلا عن تفشي أشكال من الفساد المالي (خاصة بعض المجموعات التي كانت مرتبطة بقيادات في الخارج)، وتراجع مستوى التعليم بشكل خطير.
ومن ناحية ثانية فإن مقولة “منحت الانتفاضة المرأة الفلسطينية مكانة متقدمة” بحاجة إلى مراجعة وتدقيق، فما حدث فعليا أنَّ المرأة هي التي انتزعت تلك المكانة دون منحة من أحد، ودون قرارات عليا، فمارست دورها النضالي في مواجهة الاحتلال بتلقائية وبشكل شجاع، لكنها عجزت عن ممارسة دور نضالي ضد القيم المجتمعية السائدة التي تنتقص من مكانتها ودورها، وربما هذه لم تكن من ضمن أولوياتها آنذاك.
بعد قيام السلطة الوطنية (1994) حصلت تغييرات مجتمعية كثيرة، منها ما هو إيجابي وتقدمي، ومنها ما هو سلبي ورجعي.. فالعشائرية تم إحياؤها من جديد، ومن خلال هيئة خاصة، وأُعيد الاعتبار لبعض القوى الرجعية التي تم تحييدها أثناء الانتفاضة الأولى، وبرزت قوى اقتصادية وأمنية جديدة أخذت تسيطر على إيقاع الحياة السياسية والاجتماعية.
لكن الحياة المدنية بمفاهيم العصرنة والحداثة أُعيدت من جديد، ولو شكلانيا، والسبب الطبيعة المدنية شبه العلمانية لمنظمة التحرير وفصائل العمل الوطني، وبسبب الثقافة المتقدمة نسبيا التي حملها “العائدون” القادمون من الحواضر العربية مثل لبنان وسورية وتونس وبعض الدول الأوروبية، ونقلهم لأنماط الحياة التي اعتادوا عليها في تلك الأقطار؛ ما شكّل صدمة لبعض الأوساط ذات الثقافة الريفية في البداية، واعتراض بعض القوى التقليدية (عشائرية ودينية).. إلا أن التغيير في هذا الجانب كان قد حصل فعليا، وبدأ يتسارع بخطى حثيثة مع إيقاع العولمة وثورة المعلوماتية والميديا الرقمية، وبتأثير منها..
في الانتفاضة الثانية (2000)، والتي بدأت كمقاومة شعبية سلمية، وسرعان ما تحولت إلى انتفاضة مسلحة، عاش المجتمع الفلسطيني ما يشبه أجواء حرب حقيقية، وفي أجواء الحرب وما يصاحبها من سقوط ضحايا وتدمير واهتزاز الثقة بالمستقبل، يلجأ الناس عادة إلى الدين، ولكن إلى جانب الغيبيات منه، وتصبح الفرصة أكبر لتقدم القوى الدينية (الإسلام السياسي). ما حدث فعلا.
حتى أن حركة فتح عوضا عن تمسكها بطبيعتها التعددية المنفتحة شبه العلمانية صارت تنافس حماس في تبني بعض القيم الدينية والاجتماعية المحافظة.
في قطاع غزة، ونتيجة خضوعه لحصار ظالم ولسيطرة القوى الدينية تراجعت القيم المدنية إلى درجة باتت تنذر بانهيارات مجتمعية.
سيظل التغيير المجتمعي متعثرا وربما متعذرا ما لم نحسم العلاقة ما بين التحرر الوطني والتحرر الاجتماعي، بحيث نجعلهما قرينين لا يقبلان الانفكاك، يتقدمان معاً جنباً إلى جنب، وهذا يتطلب خلق حالة متقدمة من الوعي المجتمعي، والذي هو شرط نجاح التغيير.. وهذا الوعي قائم على فكرة أنّ جوهر ومضامين مفهوم التحرر واحدة؛ أولها: إعلاء قيمة الإنسان باعتباره هدفاً وركيزة عملية التحرير، وهذا يعني أن المقاومة وجدت لخدمة الإنسان، وليس العكس، وثانيها: إعلاء قيمة الحرية، فالحرية بكل معانيها هي الهدف الأسمى، وثالثها: الإيمان بأن تحرر المرأة ليس شأنا نسويا بل هو قضية مجتمعية، وإرجاء تحرير المرأة يعني إرجاء تحرير الوطن. ورابعها: العمل على تفكيك النظام البطريركي القائم على هيمنة العقل الذكوري المتسلط على المرأة والأطفال. وخامسها: الإيمان بالعدالة الاجتماعية، والتعددية، وسيادة القانون، وترسيخ قيم المواطَنة.. وطبعا كل ذلك من منظور تحرري إنساني وتقدمي شامل، وضمن مسار مقاوم.. وخلاف ذلك يعني استبدال الاحتلال بنظام استبدادي.

ما رأيك؟
رائع0
لم يعجبني0
اعجبني0
غير راضي0
غير جيد0
لم افهم0
لا اهتم0