لم يسبق للدولة الإسرائيلية أن خاضت حرباً متواصلةً استمرّت عاماً ونيّفاً، وتكبّدت فيها خسائر عسكرية لا يُستهان بها، بالرغم من الهوة الهائلة في ميزان القوى بين طرفي المواجهة في هذه الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وعلى الشعب الفلسطيني عامةً، وعلى القوى المساندة له، وهي الحرب التي شنّتها إسرائيل إثر عملية “طوفان الأقصى” التي قامت بها (كتائب القسّام) وقوى مقاومة أخرى في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
أطول حروب إسرائيل
فالعدوان الثلاثي على مصر العام 1956، والذي كانت إسرائيل المبادر الميداني الأول في إطاره، حيث قام جيشها باحتلال قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء مقترباً من الضفة الشرقية لقناة السويس، لم تدم فترة القتال فيه سوى أيامٍ قليلة… وحرب حزيران/ يونيو 1967 التي واجهت فيها إسرائيل عدة جيوشٍ عربية لم تدم سوى بضعة أيام، وأطلق الإسرائيليون عليها تسمية (حرب الأيام الستة)… وحرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973، التي اعتُبرت في حينه استثنائية في مدّتها، استمرّت زهاء الثلاثة أسابيع… وحرب حزيران/ يونيو 1982 التي ابتغت إسرائيل فيها فرض سيطرتها على لبنان وتوجيه ضربةٍ قاصمة لقوى منظمة التحرير الفلسطينية استمرّت بمجملها، بما في ذلك فترة الحصار على بيروت الغربية، أقلّ من ثلاثة أشهر… وحرب إسرائيل على لبنان في صيف العام 2006 دامت أقلّ من خمسة أسابيع. بينما حروب إسرائيل على قطاع غزة منذ العام 2008 كانت تستغرق ما بين أيامٍ قليلة وبضعة أسابيع لا تتجاوز الشهرين (الحرب على غزة في صيف العام 2014).
ومعروف أن إسرائيل تستصعب الاستمرار في حربٍ طويلة الأمد، وتحتاج عادةً إلى توفّر دعمٍ خارجي، مالي وعسكري، متواصل في حال حدوث حربٍ كهذه، وهو دعمٌ يتأتّى بالأساس من الولايات المتحدة. فحروب إسرائيل الكبيرة تعتمد عادةً على تعبئة الاحتياط، الذي يتشكّل من إسرائيليين يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية، سواء قطاعات الإنتاج أو الخدمات، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا العالية، الذي يشكّل أحد المصادر المهمة في الناتج القومي لإسرائيل. وهذه التعبئة لها، بالطبع، كلفة اقتصادية عالية لا تستطيع إسرائيل تحمّلها بمفردها.
والى جانب الزمن الذي شغلته الحرب الإسرائيلية الجديدة على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني عامةً، وعلى القوى المساندة له، ومسألة الخسائر الاقتصادية، هناك الخسائر البشرية، وتحديداً في صفوف الجيش الإسرائيلي. فالأرقام الرسمية الإسرائيلية، والتي هي على الأغلب مخفّفة لاعتباراتٍ معنوية، للتكلفة البشرية للحرب الجارية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، هي أرقامٌ باهظة بالمعيار الإسرائيلي، سواء فيما يتعلّق بعدد القتلى أو أعداد الجرحى والمصابين والمعاقين الدائمين في صفوف الجيش. ووفق الأرقام التي أعلنتها إسرائيل، تجاوزت الخسائر العسكرية لهذه الحرب خسائر إسرائيل في حرب العام 1967 (رسمياً أقلّ من 680 عسكرياً)، مع العلم بأن هناك تفاوتاً هائلاً في ميزان القوى وأدوات الصراع بين الطرفين المتواجهين في هذه الحرب الأخيرة (الجيش الإسرائيلي، من جهة، وقوى المقاومة الفلسطينية والقوى المساندة لها، من الجهة الأخرى)، لا يقارن بميزان القوى في تلك الحرب الأقدم.
حروبٌ لم تنقطع على شعب
فلسطين طوال مئة عام ونيّف
ومع انه من الواضح أن إسرائيل، والحركة الصهيونية ومجموعاتها المسلّحة قبل قيام الدولة، لم تنفك تحارب الشعب الفلسطيني منذ أكثر من قرنٍ من الزمن، وخاصةً منذ صدور وعد بلفور وسيطرة بريطانيا على فلسطين في نهايات الحرب العالمية الأولى وتولّي البريطانيين الانتداب على البلد ورعايتهم ودعمهم للاستعمار الاستيطاني الصهيوني فيه، إلا أن الحرب الإٍسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة وبعض مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، والمحيط الجغرافي، وخاصةً لبنان، لها سماتٌ خاصة. فقد تميّزت بوحشيةٍ مكشوفةٍ استثنائية، خاصةً في مجال استهداف المدنيين بالجملة وبشكلٍ متعمّد، والتدمير المنهجي للأبنية السكنية والمؤسسات والمرافق العامة والبنى التحتية، وفرض حصارٍ محكم على سكان غزة وصل إلى حدّ قطع الماء والكهرباء والتموين الغذائي والدوائي وتدمير كل مقومات الحياة في القطاع. وشهد عددٌ من مخيمات الضفة الغربية المحتلة (بما فيها القدس الشرقية) وبعض بلداتها ومدنها نماذج مصغّرة من هذا التوحّش في البطش المكثّف والتدمير المنهجي. كما شهد لبنان، من بين البلدان المساندة لشعب فلسطين في هذه الحرب، تصعيداً غير مسبوق في كثافة القتل والتدمير فيه، خاصةً منذ أواسط أيلول المنصرم، شمل عدة مناطق لبنانية، بما في ذلك العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، ومناطق لبنان الشرقية وبعض المناطق الشمالية، علاوةً على كافة المناطق الواقعة إلى الجنوب من بيروت.
فكما بات معروفاً وموثّقاً على نطاقٍ واسع، قامت العصابات الصهيونية المسلّحة قبل قيام دولتها بالعديد من عمليات (التطهير العرقي)، وهي عملياتٌ بلغت ذروتها في الفترة الزمنية التي تلت التصويت على قرار التقسيم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر تشرين الثاني 1947، وتواصلت طوال فترة المواجهات المسلّحة وحتى توقيع اتفاقات الهدنة مع الدول العربية المجاورة خلال العام 1949، واستمرّت بعد ذلك متّخذةً أشكالاً متعدّدة ومتنوعة. وهو ما وثّقه العديد من المؤرّخين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين، وحتى، في العقود الأخيرة، بعض المؤرّخين الإسرائيليين المناهضين للصهيونية، وخاصة إيلان بابيه في كتابه الشهير “التطهير العرقي في فلسطين”، بعد أن كانت آلة الدعاية الصهيونية، وآلات الترويج والتضليل المتجاوبة والمتواطئة معها في الولايات المتحدة ودولٍ أوروبية وغير أوروبية أخرى قد عملت على طمس الحقائق فيما يتعلّق بمجريات تلك الحرب وما ارتُكب خلالها من جرائم بحقّ الشعب الفلسطيني، كما عملت على محاصرة وتهميش الكتابات الفلسطينية والعربية المؤرّخة لهذه الممارسات لزمنٍ طويل.
وهذه الحرب الصهيونية على الشعب الفلسطيني لم تتوقّف بعد قيام دولة إسرائيل على الإطلاق، كما ذكرنا، واستمرّت بأشكالٍ متنوّعة وفي محطاتٍ متلاحقة، من أجل هدفٍ واحد: إنهاء حضور الشعب الفلسطيني كشعب، سواء من خلال القتل أو التهجير والتشتيت والتمزيق، أو الترهيب والإخضاع القسري والتهميش.
جدار جابوتنسكي الحديدي:
“الصهيونية مغامرة استعمار”
عمادها القوة المسلّحة
كل ذلك كان جزءا لا يتجزأ من المشروع الصهيوني منذ ولادته، وإن لم يكن قد جرى التعبير عن ذلك بشكلٍ واضحٍ دائماً. ولعل كتابات منظّر اليمين الصهيوني فلاديمير (زئيف) جابوتنسكي منذ عشرينيات القرن العشرين كانت شديدة الوضوح على هذا الصعيد. علماً بأن ما يسمّى “اليسار” الصهيوني، وخاصةً حزب العمل وسلفه حزب “ماباي” الذي أسّسه دافيد بن غوريون في العام 1930 وقاده حتى أوائل الستينيات الماضية، لم يكن بعيداً في الممارسة الفعلية عمّا دعت إليه توصيات جابوتنسكي. ومعروف أن جابوتنسكي هو الذي استخدم، في حديثه عن عملية إخضاع الشعب الفلسطيني وتهميشه وإرغامه على التخلّي عن سيادته وحقوقه على أرض وطنه، وعملياً إلغاء وجوده كشعبٍ، تعبير فرض “جدارٍ حديدي” عليه.
قال جابوتنسكي، فيما قال، في إحدى مقالاته التي حملت هذا العنوان، “الجدار الحديدي”، ونُشرت في العام 1923: “لأنه لا يمكننا أن نعرض على عرب البلاد وعلى كل العرب أي تعويضٍ مقابل البلاد، لذلك يجب ألّا تخطر بالبال إمكانية التوصّل إلى موافقةٍ طوعية من قبلهم. ولهذا يجب أن يتواصل الاستيطان الصهيوني خلافاً لرغبة السكّان الأصليين (عرب البلاد). وبناءً على ذلك، بالإمكان مواصلته وتطويره فقط بواسطة […] جدارٍ حديدي لن يكون باستطاعة السكّان المحليين اختراقه”. وقال أيضاً: “كل استعمار، حتى ذلك الأكثر محدوديةً، ينبغي أن يستمرّ في تحدٍ لإرادة الشعب الأصلي. لذلك يستطيع أن يستمرّ وينمو فقط خلف متراس القوة الذي يشتمل على جدارٍ حديدي لا يستطيع السكّان المحليون أبداً اختراقه. هذه سياستنا العربية. وتقديمها بأي شكلٍ آخر سيكون نفاقاً”… وأضاف: “الصهيونية هي مغامرة استعمار، ولذلك فهي تقوم أو تسقط من خلال مسألة القوة المسلّحة. من المهم أن تتحدّث العبرية، ولكن، لسوء الحظ، من الأهمّ حتى أن تكون قادراً على إطلاق النار”.
وبعد أكثر من مئة عامٍ على كتابة هذه الكلمات، التي تتحدّث بدون مواربة عن مشروعٍ “استعماري”، كما كان عليه الحال أيضاً في كتابات مؤسّس الصهيونية السياسية تيودور هيرتسل، من الواضح أن القيادات الصهيونية (والإسرائيلية بعد العام 1948) المتعاقبة سلكت هذا الطريق الذي أوصى به جابوتنسكي. وإن كان التيار “العمالي”، الذي أسّسه وقاده بن غوريون، وتولّاه بعده أتباعه في هذا التيار الذين حكموا إسرائيل حتى العام 1977 وعادوا للحكم لسنواتٍ قليلة خلال التسعينيات الماضية، سعى لتقديم هذه الممارسة بشكلٍ مغاير، بما يبرّر حديث جابوتنسكي عن “نفاق”. وهكذا يمكن القول، إن غلبة اليمين الصهيوني الواضحة على الساحة السياسية الإسرائيلية بعد العام 1977، وبشكلٍ متواصل منذ العام 2001، كانت في الواقع توجّهاً لاستبدال سياسة النفاق والازدواجية بين القول والممارسة بسياسةٍ تقوم على التناغم بين “التغليف” اللفظي – الدعاوي والممارسة الفعلية. فجدار جابوتنسكي الحديدي، كما عرّفه هو نفسه، كان في خلفية ممارسات بن غوريون وورثته، وإن شهدت العقود الأخيرة اعتماداً أكثر صراحةً لمضامين هذا التعبير وممارسةً معلنة لسياسة فرض الوقائع على الأرض بقوة السلاح، اقتداءً بالتجارب الاستعمارية السابقة في العالم. وهو ما نسمعه، اليوم، بوضوحٍ شديد في تصريحات رموز اليمين الصهيوني الأكثر تطرّفاً من أمثال إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وأضرابهما، كما نراه في الممارسة الفعلية لحكومات إسرائيل المتعاقبة، بما فيها وخاصةً حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، في خوضها لحربها الدموية الأخيرة.
قناعات نتنياهو… وأفكار
بن غفير وسموتريتش
ومن المفيد في هذا السياق أن نؤكّد على أن جوهر ممارسات بنيامين نتنياهو منذ أن وصل إلى رأس السلطة للمرة الأولى في العام 1996، وبشكلٍ متزايد بعد أن عاد إلى رئاسة الحكومة في العام 2009، لم يكن قط بعيداً عن قناعات من يُوصفون، اليوم، باليمين المتطرف. ففي الممارسة الفعلية، يتكشّف أن مواقف وقناعات نتنياهو لم تكن تختلف كثيراً عن مواقف هذا التيار الصهيوني الاستعماري اليميني المتطرف في عنصريته ودمويته.
ويمكن التذكير، في هذا السياق وعلى سبيل المثال لا الحصر، بأن نتنياهو كان قد دعا علناً في العام 1989 إلى تهجير الشعب الفلسطيني خارج وطنه، أي ممارسة ما يسميه الإسرائيليون الـ”ترانسفير”. ففي خريف العام 1989 (تحديداً يوم 16 تشرين الثاني من ذلك العام)، تحدّث نتنياهو، الذي كان آنذاك نائباً لوزير الخارجية في الحكومة التي كان إسحق شامير يترأسها، في ندوةٍ أمام طلاب جامعة بار إيلان في النقب، بعد أسابيعَ قليلة على المواجهات التي شهدتها الصين، وخاصةً ساحة (تيين أن مِن) الشهيرة في العاصمة بيجينغ، في أوائل حزيران من ذلك العام، قال فيها، إن على إسرائيل استغلال قمع الصين للتظاهرات، حين كان انتباه العالم مشدوداً للأحداث في ذلك البلد، من أجل القيام بعمليات طردٍ كبيرة للعرب في المناطق (يقصد الأراضي المحتلة العام 1967). وأضاف، حسب ما نقلته صحيفة “عل هَمِشمار” – عدد يوم 24/11/1989-: “لكن، لأسفي، لم يدعم (وزراء الحكومة) السياسة التي تبنّيتها وما زلت أواصل الدعوة لتنفيذها”. ونشرت صحفٌ إسرائيلية أخرى، مثل “معاريف” و”جيروزالم بوست”، تغطياتٍ لمداخلة نتنياهو هذه بنفس المضمون.
وبالرغم من الخبرة السياسية التي راكمها نتنياهو خلال العقود الثلاثة ونيّف التالية على هذا الحديث بما جعله أكثر انتباهاً بعض الشيء لما يتفوّه به علناً، وإن اقتضى ذلك اللجوء إلى الكذب الفاقع، يمكن القول، إن قناعاته الفعلية لم تتغيّر جوهرياً منذ ذلك الحين. وهو ما تُظهره ممارسة جيشه في قطاع غزة بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهي ممارسةٌ واضحة الأهداف: محاولة قتل وإعاقة العدد الأكبر من المواطنين الفلسطينيين في القطاع، بمن فيهم الأطفال والنساء، وتهجير من يتبقى منهم حياً، إن لم يكن في الأمد المباشر، ففي المستقبل، بعد جعل قطاع غزة مكاناً غير صالحٍ بالمطلق للعيش البشري. وهي الأهداف ذاتها التي يُفصح عنها علناً أمثال بن غفير وسموتريتش وغيرهما من اليمين الصهيوني، بما في ذلك زملاء نتنياهو في حزب “الليكود”، وريث المدرسة الصهيونية اليمينية التي أسّسها جابوتنسكي. وبطبيعة الحال، في حال نجاح هذا المخطط مع شعب القطاع، وهو نجاحٌ غير مضمون بالطبع، سيكون على جدول الأعمال التالي العمل على تطبيق الوصفة ذاتها على بقية الشعب الفلسطيني المتواجد على أرض وطنه، بدءا بالضفة الغربية المحتلة.
وكما يعلم كل من تابع وقرأ تاريخ “النكبة” الفلسطينية في أواخر الأربعينيات الماضية، فإن مثل هذه الأهداف ليست جديدةً في إطار المشروع الصهيوني. فموضوع الـ”ترانسفير” و”الإبادة السياسية” politicide للشعب الفلسطيني – كما سماها أحد المؤرّخين اليساريين – كانا حاضرَين تماماً في تلك الفترة وما بعدها. ومن الواضح أن أغلبيةً ساحقة من الطاقم السياسي الصهيوني الإسرائيلي ومن الجمهور في إسرائيل ما زالت تتطلّع إلى تحقيق هذه الأهداف، مع العلم بأن “الإبادة السياسية” يمكن أن تتّخذ طابع الإبادة الجسدية الفعلية genocide في بعض الظروف، كما هو الحال عليه في هذه الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
العالم يتغيّر…
لكن مشكلة هؤلاء جميعاً أن الشعب الفلسطيني، اليوم، لم يعد كما كان إبان “النكبة”، وأن العالم كذلك تغيّر منذ العام 1948، وحتى منذ العام 1989، في عدة مجالات، وليس في كلّها بالطبع. وإذا كان الوضع العربي الرسمي قد تغيّر نحو الأسوأ خلال العقود الأخيرة، وخاصةً بعد حرب العام 1967 ومطلع السبعينيات الماضية، كما تجسّد في اتفاقات التطبيع العربية – الإسرائيلية التي تحقّق أوّلها في العام 1979 وتلاحقت بعد ذلك حتى مطلع عشرينيات القرن الحالي، فإن الرأي العام العالمي، بوسائل الإعلام العصرية سريعة الانتشار، قد تغيّر كثيراً بالاتجاه الآخر، وبات أكثر حساسيةً تجاه الانتهاكات الفجّة لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها. وهو ما أظهرته الحراكات الواسعة التي شهدتها الجامعات والمدن والبلدات في أنحاء العالم، بما في ذلك في بلدان أوروبا والولايات المتحدة نفسها. صحيح أن الكوابح الرسمية في البلدان الغربية الأساسية ما زالت قائمةً وفعّالة في سياق حرص حكام هذه البلدان على استمرارية المشروع الصهيوني الاستعماري ودور الدولة الصهيونية الإقليمي والعالمي في إطار مشروع الهيمنة الاستعمارية الغربية الأوسع، لكن الحركات الشعبية باتت أكثر قدرةً على التقاط المستجدّات وفهمها والتحرّك ضدها في بعض الحالات.
وفي هذا السياق، نستذكر قولاً ورد على لسان أحد كبار الضباط الإسرائيليين إبان الانتفاضة الفلسطينية الأولى في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، حين أبدى انزعاجاً من تغطيات شبكات التلفزيون العالمية لأحداث الانتفاضة ولعمليات البطش الإسرائيلية التي واجهتها، قائلاً ما معناه، إنه لو كان هناك تلفزيون في العام 1948 لما قامت دولة إسرائيل! وهو ما يؤكّد أهمية وسائل الإعلام والنشر والتواصل، والتي لم تنفك تتطوّر منذ ذلك الحين، ليس فقط من خلال الانتشار الواسع لشبكات وأجهزة التلفزيون في أنحاء العالم خلال العقود الأخيرة، وإنما كذلك عبر تطور وسائل الاتصال المختلفة بما فيها شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ما بات يتيح نقل الأخبار والصور وحتى المشاهد الحيّة إلى أنحاء العالم في أقصر الأوقات.
ويمكن أن نشير في هذا السياق، على سبيل المثال لا الحصر، إلى التحوّل الكبير الذي شهدته القارة الأميركية اللاتينية منذ العام 1947، حين لعبت دول القارة دوراً رئيسياً في حسم التصويت لصالح قرار تقسيم فلسطين آنذاك، بينما باتت الآن في غالبيتها مؤيّدةً لنضال الشعب الفلسطيني، وذهب عددٌ من دول القارة الرئيسية خلال الأشهر الماضية إلى حدّ قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل والانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية احتجاجاً على جرائم الإبادة التي ترتكبها الدولة الصهيونية في حربها على شعب قطاع غزة، والشعب الفلسطيني عامةً. كما صوّتت غالبيةٌ ساحقة من هذه الدول الأميركية اللاتينية لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتُمد يوم 18 أيلول الأخير والداعي إلى الالتزام بتوصيات محكمة العدل الدولية الأخيرة، وإنهاء الوجود الٍإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية التي احتُلت في العام 1967 خلال عامٍ من صدور القرار. وما حصل في أميركا اللاتينية حصل أيضاً مع مناطق ودول أخرى في أنحاء العالم.
ومن الواضح أن هذه التطوّرات على صعيد سرعة نشر المعلومات وتنامي وسائل الاتصال تزعج أصحاب القرار في الدولة الصهيونية، ما يفسّر المحاصرة الإعلامية التي فرضوها على قطاع غزة ومنعهم دخول الصحافيين الأجانب إليها، واستهداف جيشهم للصحافيين ومراكزهم في القطاع، وفي أنحاء الأراضي الفلسطينية، وحتى في لبنان. ويراهن أصحاب القرار في إسرائيل، على الأغلب، في حال تمكّنهم من استكمال أهداف حربهم الإبادية في قطاع غزة، وفي مناطق أخرى، على إمكانية نسيان الجمهور الواسع في أنحاء العالم لما جرى مع مضي الوقت وتلاحُق الأحداث في مناطق العالم المختلفة، كما حصل مراراً بعد المجازر المتكرّرة التي شهدتها فلسطين ومحيطها الجغرافي في العقود الماضية. كما يراهنون على التواطؤ الواسع لحكام الدول الغربية، وخاصة حكام الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية الرئيسية، الذين يعتبرون الدولة الصهيونية امتداداً للمعسكر الغربي وحصناً منيعاً يدافع ويصون مصالح هذا المعسكر وأطماعه في المنطقة الشرق متوسطية ومحيطها، وشريكاً مهماً لهم في الصراع العالمي الجاري منذ عدة سنوات لإعادة رسم التوازنات والخارطة السياسية الجديدة للعالم.
ويراهنون كذلك على ترهيب شعوب المنطقة المحيطة بهم، العربية وغير العربية، من خلال ممارسة البطش غير المحدود وغير المقيّد بالقوانين الدولية، وعلى ابتزاز حكّام المنطقة، ورشوة من تُمكن رشوته منهم. وهي سياساتٌ اتّبعوها في حرب العام 1948، وفي الحروب والمواجهات اللاحقة، في إطار نظرية “الجدار الحديدي” إياها، حين فرض تضامن شعوب المنطقة المحيطة مع شعب فلسطين توسيع حروب هذا “الجدار الحديدي” لتشمل هذا المحيط، القريب والأبعد. وهو ما رأيناه خلال الأشهر والأسابيع الماضية من استهدافاتٍ لبلدان المحيط، وبشكلٍ خاص استهداف لبنان وقوى المقاومة هناك، والعمل على تصفية أبرز قادتها وكوادرها، بمن فيهم الأمين العام لـ”حزب الله” والعديد من قادة الحزب، وحتى المواطنين المدنيين في البلد على نطاقٍ واسع، وهو التصعيد الذي بدأ مع تفجير أجهزة الاتصال يومي 17 و18 أيلول الماضي والقصف الواسع النطاق لمختلف مناطق البلد، بما في ذلك بعض أحياء العاصمة بيروت.
ويبدو أن التعاطف الواسع الذي عبّر عنه العديد من حكّام الدول الغربية مع الدولة الإسرائيلية غداة عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في غلاف غزة أشعر حكّام إسرائيل بأنه سيكون باستطاعتهم التصرّف بوحشيةٍ لا سقف لها تجاه الشعب الفلسطيني ومن يمكن أن يسانده من شعوب المنطقة، دون رادعٍ أو حساب، مستثمرين هذا الانحياز ليستعيدوا المناخات التي سادت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وانكشاف حجم الاضطهاد الذي لحق بالمجتمعات اليهودية في عددٍ من الدول الأوروبية، والذي استغلّته الحركة الصهيونية لدفع مشروعها الاستعماري بقوةٍ إلى الأمام، ومتوقّعين تساهلاً معهم من قبل الحكومات الغربية والرأي العام في دولها، في تجديدٍ معاصرٍ لنهج الاستثمار الذي سماه أحد المثقّفين اليهود اليساريين بـ”صناعة الهولوكوست”.
“جدارٌ حديدي” غير متوقّع!
لكن مشكلة المشروع الصهيوني، كما بات مرئياً أمام أعين العالم كله، ما عدا الجمهور الإسرائيلي الواسع المضلَّل والمجيَّش والمسكون بأيديولوجيا التفوّق الإثني – الديني والأساطير الماورائية، أن نظرية جابوتنسكي الداعية إلى إرهاب وتطويع شعب البلد الأصلي، في امتدادٍ للمشاريع الاستعمارية السابقة في أنحاء العالم، وخاصةً نماذج القارة الأميركية ومناطق مثل أستراليا ونيوزيلندا، جاءت متأخرةً زمنياً. ففي الفترة ذاتها التي بدأ فيها المشروع الصهيوني يشقّ طريقه على أرض فلسطين برعاية الانتداب البريطاني في عشرينيات القرن المنصرم، كانت شعوب العالم المستعمَرة، في قارّتي آسيا وإفريقيا خاصةً، قد بدأت تكثّف حراكاتها للانتفاض على هذه السيطرة الاستعمارية وتحقيق تحرّرها الوطني.
ومن المفترض أن يكون الآن مرئياً لجمهور المشروع الصهيوني وأنصاره في الدول الغربية أن الشعب الفلسطيني تحديداً أظهر، خلال قرنٍ ونيّف من مقاومة أجياله المتعاقبة لهذا المشروع الاستعماري ولمحاولة إبادته (السياسية والفعلية) وتغييبه عن خارطة المنطقة، أنه قد شكّل “جداراً حديدياً” فعلياً بات يصطدم به المشروع الصهيوني، بالرغم من الانهيارات التي شهدتها المنطقة العربية المحيطة من خلال انحياز بعض حكامها لصالح التعايش، وأحياناً حتى تقاطع المصالح والمصائر، مع المشروع الصهيوني. وإذا أضفنا لذلك استمرارية التضامن الشعبي العربي الواسع، وتعاطف شعوب المحيط الأوسع، مع شعب فلسطين وقضيته، والدور الحيوي الذي باتت تلعبه قوى تحرّرية عربية، وغير عربية، في المحيط، في لبنان واليمن والعراق وغيرها من البلدان، والتحوّلات التي يشهدها العالم مع التغييرات الجارية في موازين القوى العالمية لغير صالح المعسكر الغربي المتبنّي للمشروع الصهيوني، وحتى التحوّلات الجارية داخل دول أوروبا وداخل الولايات المتحدة نفسها، بما في ذلك في أوساط الجيل الجديد من الأميركيين اليهود، يبدو واضحاً أن المشروع الصهيوني دخل نفَقاً لم يعهده من قبل.
وهو ربما ما يفسّر ردود الفعل الهستيرية الدموية لحكام إسرائيل وسياسات القتل والتدمير الواسعة التي اتّبعوها في الأراضي الفلسطينية كما في بلدان المحيط، وخاصة في لبنان، خلال هذه الحرب الشرسة، في رهانٍ متجدّد على إحياء فعالية جدار جابوتنسكي لضمان بقاء المشروع الصهيوني الاستعماري على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأمن وسلامة شعوب المنطقة المحيطة.
وماذا بعد…؟
وإذا استعدنا بعض المشاريع الاستعمارية المعاصرة الأخرى، يمكن أن نقول، إن جمهور المشروع الصهيوني في إسرائيل أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الإقرار بضرورة الاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني وبحقوقه الوطنية، والقبول بما تعرضه قواه المنظمة منذ أكثر من خمسة عقود، وهو إنهاء احتلالات العام 1967 والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولةٍ مستقلة خاصة به وبحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، وإنهاء نظام “الأبارتهايد” في عموم فلسطين التاريخية… وإما استمرار المقاومة والمواجهات العنيفة في فلسطين والمنطقة المحيطة طالما استمرّ هذا الظلم الرهيب اللاحق بالشعب الفلسطيني وهذا الافتئات والتعدّي على سيادة شعوب المنطقة وأمنها وسلامتها.
طبعاً، ما جرى داخل إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي خلال هذا العام المنقضي لا يبشّر بكثيرٍ من الخير على هذا الصعيد في الأمد القصير. حيث تُظهر استطلاعات الرأي تأييداً كاسحاً في الرأي العام الإسرائيلي لسياسات البطش والإبادة التي تمارسها قوات حكومة نتنياهو وتدعمها الغالبية الساحقة من القوى الصهيونية الأخرى، بما فيها تلك التي تعتبر نفسها معارضةً لبنيامين نتنياهو وحكومته، مثل حزب رئيس أركان الجيش الأسبق بيني غانتس، الذي صوّت في الكنيست الإسرائيلي يوم 18 تموز الماضي مع أنصار نتنياهو ضد مبدأ الدولة الفلسطينية المستقلة.
لكن المناخ الداخلي الإسرائيلي قد يتغيّر، كما حصل في جنوب إفريقيا في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات الماضية… وقد لا يتغيّر، كما حصل مع غالبية المستوطنين الأوروبيين الذين كانوا في الجزائر قبل تخلّصها من النظام الاستعماري في العام 1962. وفي الحالة الأخيرة، يُفترض أن يتواصل العمل على تكثيف كل أشكال الضغوط، بما فيها الضغوط الخارجية، على أصحاب القرار والشأن في الدولة الصهيونية، بما في ذلك وخاصةً من قبل الرأي العام والقوى المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني في أنحاء العالم، بما يشمل الدول الغربية نفسها، على غرار ما حصل في الثمانينيات الماضية مع جنوب إفريقيا، حين قاد ضغط الرأي العام العالمي، بما في ذلك الرأي العام في الولايات المتحدة، إلى تحوّلٍ في مواقف حكام هذه الدول، وخاصة موقف إدارة رونالد ريغان في واشنطن، تجاه النظام العنصري في ذلك البلد، ما مهّد الطريق لإنهاء نظام “الأبارتهايد”.
هذا، دون أن نغفل بأن الحكومات الأميركية المتعاقبة، وحكوماتٍ أوروبية وغربية أخرى، ما زالت تمتنع عن ممارسة أي ضغطٍ جاد على حكام إسرائيل، إن لم تكن متواطئةً فعلياً في حالاتٍ كثيرة مع مشاريع العدوان الإسرائيلية. ولكن ذلك قد يتغيّر، مع التغيّرات الحاصلة على صعيد الرأي العام العالمي، وخاصة في أوساط الأجيال الجديدة، بما في ذلك في عموم الدول الغربية، وفي الولايات المتحدة نفسها.
والأمر قد يحتاج إلى بعض الوقت في هذا البلد الأخير، المدافع الأشرس عن المشروع الصهيوني واستمراريته في المنطقة الشرق متوسطية، لكي يتحقّق انعكاسٌ جديٌ لهذا المزاج الشعبي المتغيّر على مستوى الهيئات التشريعية والتنفيذية المقرّرة، في بلدٍ يحكمه نظامٌ انتخابي يلعب فيه المموّلون وأصحاب الثروات دوراً أكبر بكثير من أصوات جمهور الناخبين العاديين وإرادة وتوجّهات القواعد الشعبية. ولعل أحد الأمثلة الأكثر سطوعاً على ذلك في الأسابيع الماضية هو رصد الأموال الهائلة واعتماد الوسائل الملتوية من قبل “اللوبي الصهيوني” – إيباك AIPAC – في الولايات المتحدة لإسقاط بعض المرشّحين التقدميين الأقوياء المناهضين للسياسات الإسرائيلية من أعضاء الحزب الديمقراطي في الانتخابات التمهيدية للحزب لمنع تجديد ترشّحهم لعضوية مجلس النواب حتى قبل الوصول إلى انتخابات تشرين الثاني 2024، وفي المقدمة النائبان التقدميان جمال بومان وكوري بوش.
يبقى أن من مصلحة الشعب الفلسطيني، وخاصةً شعب قطاع غزة الذي عاش جحيماً غير مسبوق في عدة حروبٍ متلاحقة خلال العقدين الماضيين، وخاصةً في هذه الحرب الدموية الرهيبة الدائرة منذ زهاء العام، اختزال زمن المعاناة والوصول إلى حلٍ يحترم حقوقه وكرامته في أقرب الأوقات. ما يتطلب العمل على تكثيف الضغوط على حكام إسرائيل وأصحاب القرار فيها لكبح العقلية الاستعمارية الاستعلائية العنصرية، وفرض الإقرار بوجود شعبٍ أصلي في البلد لا تفلح معه نظرية جابوتنسكي، شعب أثبت خلال أكثر من قرنٍ من الصمود والمقاومة التي لم تتوقّف حلقاتها المتلاحقة أنه، بالفعل، “جدارٌ حديديٌ” غير قابل للكسر، ولن يستسلم أبداً للواقع الاستعماري العنصري، واقع الاستعباد ونظام التراتبية العنصرية “الأبارتهايد”، ولن يقبل بمحو وجوده وحقّه الضارب في التاريخ في أرض وطنه.
لكن الأمور قد لا تسير بهذا الاتجاه في الأمد القريب، وقد تحتاج لفترةٍ زمنيةٍ أطول. فبالرغم من أن إسرائيل تعرّضت خلال هذا العام من المواجهات لهزّةٍ غير مسبوقة، ستؤدّي بالضرورة إلى نزيفٍ سكاني مباشر، أو مؤجّل، عبر تزايد الهجرة إلى بلدانٍ غربية، وربما، مع مضي الزمن، إلى تنامي تياراتٍ أكثر عقلانيةً لدى الجمهور الإسرائيلي تبدأ في التفكير بضرورة احترام حقوق الشعب الأصلي، وإن يكن تنامي تياراتٍ كهذه ليس أمراً حتمياً في ظل التشويه المريع الذي أحدثته القيادات الصهيونية المتعاقبة في وعي ونفسيات الجمهور الإسرائيلي.
وفي كل الأحوال، يبدو من شبه المؤكّد أن نواةً يمينية متشدّدة ومتطرّفة ستبقى موجودةً في الدولة الصهيونية وستعمل على تصعيد العنف والبطش، ليس فقط ضد الشعب الفلسطيني، وإنما ضد كل القوى والشعوب التي تسانده في المنطقة، بدءا بشعب لبنان، بما يفتح المجال أمام المزيد من المعاناة لشعوب المنطقة، قبل أن ينتهي كل المشروع الصهيوني إلى مواجهة أزمته المستحكمة ويأخذ في التصدّع النهائي في مواجهة هذا “الجدار الحديدي” غير المتوقّع، والذي لم يكن في حسبان منظّري وقادة هذا المشروع قبل قرنٍ ونيف.

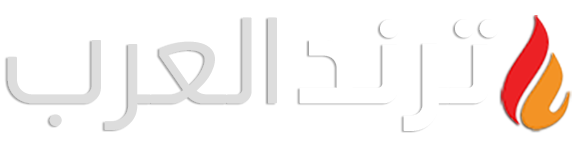


































هل لديك سؤال؟
تابعنا على السوشيال ميديا او اتصل بنا وسوف نرد على تساؤلاتك في اقرب وقت ممكن.