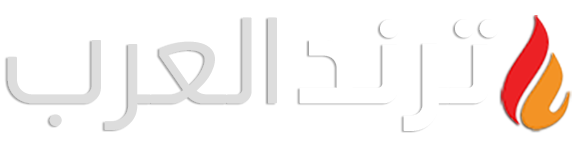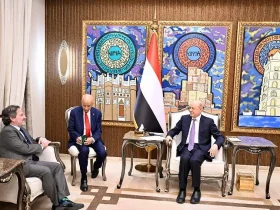أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما (إعلان دستوري) يقضي بأن يتولى رئيس المجلس الوطني مهام الرئيس في حال شغور منصب الرئيس لمدة 90 يوما تُجرى بعدها انتخابات رئاسية، وهي قابلة للتكرار إذا تعذر اجراء الانتخابات في المرة الأولى لمرة واحدة فقط بقرار من المجلس المركزي.
المرسوم مفاجئ، لكن الغرض منه غير مفاجئ، لأنه محاولة لسد أي فراغ يمكن أن ينشأ بعد شغور منصب الرئيس، لكنه يتجاهل واقع الانقسام الذي يجعل أي قرار أو قانون جوهري في ظل الحالة الاستثنائية سياسيا و غير الدستورية التي يعيشها النظام السياسي بمختلف مكوناته، إذا اتخذ دون توافق وطني ليس حلًا، وإنما يعمّق الانقسام ويوجج الصراع والتنافس على الخليفة والخلفاء بما يستدعي الان دعوات لعقد المجلس المركزي من أجل تغيير رئيس المجلس الوطني وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية خصوصا أن شغور منصب الرئيس في الظروف الحالية او مثلها لا يتيح إجراء الانتخابات في المدة المحددة في المرسوم ما يجعل الرئيس المؤقت دائم حتى اشعار آخر؛ فهو بصورة محددة يقفز عن المطلوب تحقيقه، وهو تطبيق إعلان بكين الذي وقع عليه 14 فصيلًا، ومن شأن تطبيقه أن يؤدي إلى وحدة وشرعية المؤسسات الفلسطينية كافة، بما فيها الرئاسة، ويوفر إمكانية لممارسة الصلاحيات المحددة لكل مؤسسة ولسير المرحلة الانتقالية التي ستستغرق أكثر من ١٨٠ يوما بسلاسة.
من جهة أخرى، جاء المرسوم تهربًا أو التفافًا على الضغوط العربية والأمريكية على الرئيس وهذا جيد لأنها لا تستهدف إصلاح السلطة والمنظمة لما فيه خير ومصلحة الفلسطينيين وإنما لصالح إيجاد سلطة وقيادة أو قيادات متجددة مستجيبة أكثر للشروط والمطالب الأمريكية والإسرائيلية، ولقد بدأت الضغوط منذ عامين على الأقل، بهدف تعيين حكومة مفوّضة بكامل، أو معظم، صلاحيات الرئيس، بحيث يلعب خلال الفترة الانتقالية المتبقية له دورًا فخريًا، أو يقوم بتعيين نائب رئيس يتولى فورًا مهام الرئيس، تدريجيًا بعد تعيينه، وذلك بذريعة تجنب أي فراغ سياسي ودستوري يمكن أن ينشأ إذا حدث شغور في منصب الرئيس.
وعندما كلف الرئيس الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة، قطع الطريق على سيناريو حكومة مفوّضة بصلاحيات الرئيس، كما قطع الإعلان الدستوري الطريق على سيناريو تعيين نائب رئيس. كما حدّد، بل وحسم، أسلوب وخطوات المرحلة الانتقالية بصورة أفضل على أساس أهون الشرور، بحيث تكون بعيدة عن التعيين والتوريث، وتمثل من الناحية الشكلية تضمن وحدة السلطة والضفة والقطاع وأولوية المنظمة بوصفها المرجعية العليا والمثل الشرعية الوحيد، كما تمثل انحيازًا للخيار الديمقراطي والانتخابات. وتجنب الرئيس الضغوط لتعيين نائب له بحجة وجيهة، وهي عدم وجود منصب نائب رئيس في القانون، وعدم وجود خليفة قوي معترف به من أغلبية محلية وازنة، في ظل وجود تنافس ساخن بين عدد غير قليل من المتنافسين الذين لم يتفقوا على مرشح واحد، ولا على توزيع مناصب الرئيس، التي تشمل رئاسة السلطة والدولة والمنظمة وحركة فتح. والخليفة، بصرف النظر عن شخصه، في ظل وضع الضعف والهوان والتيه والانقسام الفلسطيني، سيكون بحاجة إلى رضى وتوافق عليه، عربيًا وإقليميًا ودوليًا، وخصوصا أمريكيًا إسرائيليًا، لذلك كله اللجوء إلى رئيس المجلس الوطني الذي يمثل أعلى مرجعية ليحل محل رئيس السلطة التي تعتبر بمستوى أدنى من المنظمة وأحد أدواتها أمر يخلق من الاشكالات أكثر ما يقدم من الحلول، هذا إذا تجاوزنا أن القانون الأساسي ينص على أن يشغل رئيس المجلس التشريعي محل الرئيس في حال شغور منصبه لمدة ستين يوما كما حصل بعد اغتيال الزعيم الرئيس الراحل ياسر عرفات، ولكن هذا متعذر بعد القرار الكارثي بحل المجلس التشريعي، وبما أن رئيس المجلس المحل من فصيل آخر فهذا يستدعي بصورة أكبر التوافق الوطني على كيفية التعامل مع المرحلة الانتقالية.
تكمن الثغرة الكبيرة في الإعلان الدستوري في كونه صدر في وضع غير دستوري، وخلط بين القانون الأساسي للسلطة والنظام الأساسي للمنظمة، في وقت السلطة فيه منقسمة، وأصبحت أكثر من أي وقت مضى بلا سلطة، والمنظمة عمليًا مجمدة، حيث لم يجتمع المجلسان الوطني والمركزي منذ فترة طويلة، رغم وقوع أحداث جسيمة، أهمها طوفان الآقصى، تقتضي اجتماعات لبلورة الرؤية والاستراتيجية الوطنية الموحدة، وخطة الاستجابة للتحديات الجسيمة والفرص المتاحة.
كما تبرز إشكالية أخرى في إحالة الأمر في سد شغور المنصب الرئاسي إلى المجلس الوطني عبر الاستبدال برئيسه، كما يظهر بتكليف رئيس المجلس الوطني برئاسة السلطة في المرحلة الانتقالية، واللجوء بصورة عشوائية للمجلس المركزي عند اتخاذ قرار التمديد لفترة أخرى، انسجامًا مع قرار سابق اتخذه المجلس الوطني بصورة غير قانونية ولا شرعية بتفويض صلاحياته للمجلس المركزي المختلف عليه، ودون تحديد مدة ومجالات التفويض. وهو ما يعني عمليًا أن المجلس المركزي حلّ محل المجلس الوطني حتى إشعار آخر، وهذا قرار خطير جدا كونه يلغي أهم وأعلى مؤسسة وطنية بحجة تعذر اجتماعها، ويمسّ بهيبة وشرعية منظمة التحرير بأسرها.
ولا بدّ أن نضيف إلى ما سبق، أن فترة رئاسة السلطة انتهت في 9 كانون الثاني/يناير 2009، أي منذ ما يزيد عن 15 عامًا تقريبًا، وكذلك المجلس التشريعي، الذي تم حله بشكل غير قانوني، ولا شرعي، رغم كونه منتخبًا، وتفويض مهامه للمجلس المركزي غير المنتخب! كما أن “التشريعي” جزء من السلطة التي يحكمها القانون الأساسي، بينما “المركزي” جزء من المنظمة التي يحكمها النظام الأساسي للمنظمة. وفوق ذلك كله تم إلغاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كانت على وشك الإجراء عام 2021، وهو خطأ استراتيجي أضاع فرصة لاستعادة الوحدة (وحدة المؤسسات الديمقراطية والنظام والقيادة والقرار).
وهنا يبرز سؤال حول مدى صحة ما يؤدي إليه المرسوم من تمديد حياة السلطة كما هي، وبشكل انفرادي، وبلا توافق وطني، في حين كان المطلوب – حتى لو تحققت الوحدة بين السلطتين المتنازعتين – تغيير شكل السلطة ووظائفها والتزاماتها وموازنتها، لأن الحكومات الاسرائيلية قتلت عملية السلام، وتجاوزت كليًّا التزاماتها بموجب اتفاق أوسلو، ولا معنى لاستمرار تمسك المنظمة بالتزاماتها في هذا الاتفاق. كما أن هناك جدلًا كبيرًا، خصوصًا بعد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، حول ضرورة الانتقال إلى تجسيد مؤسسات الدولة، فالاعتراف بالدولة كنز سياسي وقانوني، والتصرف بعده يجب أن يختلف عما كان قبله.
وفي هذا السياق، لا بدّ من التأكيد على أن وضع النظام السياسي بمختلف مؤسساته غير دستوري، وفاقد للشرعية القانونية والشعبية والبرنامجية، بحيث لا ينفع الاكتفاء بالقول إن المرسوم الأخير أفضل من التعيين والتوريث، ويشكل انحيازًا للخيار الديمقراطي. فبعد سلسلة من المراسيم الانفرادية، تلك غير القانونية والمشكوك بقانونيتها كذلك، يصبح ما جرى أهون الشرور، والبحث يجب أن يتركز على وقف هذا التدهور قبل الضياع والانهيار الكبير لكل شيء وليس الإمكان فيه خصوصا أن رأس الوصاية والاحتواء يطل برأسه بقوة.
ينقلنا كل ما سبق إلى القضية الرئيسية التي يمكن تجاهل أهمية طرحها للنقاش، وهي أن النظام السياسي الفلسطيني بمختلف مكوناته، خصوصا بعد حرب الإبادة والتهجير والضم وخطة الحسم، التي تبنتها عمليًا حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، يواجه مأزقًا استراتيجيًا، وخطرًا وجوديًا، جراء وصول الاستراتيجيات المعتمدة، سواء على المفاوضات وحدها، أم المقاومة وحدها، مع الفوارق الجوهرية بينهما، إلى حائط مسدود، ومأزق استراتيجي. إذ لم يتم تحرير فلسطين كاملة، ولا تحرير الأراضي المحتلة عام ٦٧ وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بل تعمّق الاحتلال، وتوسّع الاستيطان، وتقطّعت الأوصال، وتعرضت المقدسات للعدوان والانتهاكات وتغيير مكانتها، ووقع الانقسام السياسي والجغرافي والفصل ما بين الضفة والقطاع، ووصلنا إلى كارثة إنسانية كاملة الأوصاف في قطاع غزة، لا يقلل من وقعها حجم الصمود والبطولة والمقاومة الباسلة والإنجازات المتحققة، وشبح الضم والتهجير وصفقة ترامب يتقدم ويمكن أن ينجح إذا لم يكن هناك سياسة وأداء فلسطيني مختلف جوهريا عما هو قائم.
ما سبق يستدعي تأملًا عميقًا، وحوارًا وطنيًا شاملا تمثيليا مسؤولًا، يهدف إلى إطلاق عملية مراجعة تستهدف استخلاص الدروس والعبر، وإجراء تغيير عميق في البنية والهيكلية والأداء والسياسات والأشخاص، تستند إلى بلورة رؤية شاملة قادرة على الحفاظ على ما تبقى من مكاسب ونقاط قوة، أهمها وجود نصف الشعب الفلسطيني على أرضه وإصراره على الصمود والكفاح ووجود قضية حية رغم كل شئ، وإنهاء الانقسام على أساس برنامج يجسد القواسم المشتركة والشراكة الحقيقية والحفاظ على التعددية في إطار الوحدة، بما يضمن السير بثقة وثبات على طريق الانتصار؛ فهناك فرصة عظيمة لتحويل حرب الوجود والمصير إلى نهوض تاريخي عظيم.
إن مفتاح الخلاص يكمن في كلمتين: الوفاق والشراكة، بدون احتكار للوطنية والدين والحقيقة، أو إقصاء أو تخوين أو تكفير؛ فالمشروع الاستعماري الاستيطاني يستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه وتزييف تاريخه، كما يستهدف مصادرة حاضره ومستقبله.
ويعني هذا أن تطبيق إعلان بكين، وإن لم يكن مثاليًا، ودون التقليل من الصعوبة البالغة في تطبيقه، بسبب العقبات الداخلية والخارجية، يشكل الطريق الأقرب الذي يمكن أن يؤدي إلى استكمال تحقيق الوحدة. فهذا الإعلان يتضمن تشكيل حكومة وفاق وطني، وتفعيل الإطار القيادي المؤقت، وتشكيل مجلس وطني عن طريق الاحتكام للشعب عبر الانتخابات عندما يكون ذلك مناسبًا. وطالما أن الوقت الحالي غير مناسب للانتخابات، فإن الشرعية تستمد فقط من وفاق وطني على برنامج وطني ديمقراطي وسياسات وخطط تحفظ الحقوق وتكون واقعيةً وقادرةً على التطبيق والإقلاع.
هناك أمل ونور في نهاية النفق جراء وجود مصلحة جوهرية مؤكدة للشعب بتحقيق الوحدة، وبسبب نشوء مصلحة بتحقيق الوحدة أيضا تولدت مؤخرًا، بشكل خاص، لدى معظم النخب الحاكمة أو المهيمنة في السلطة والمنظمة والفصائل ومختلف مكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لأن الكل بات يدرك أننا نواجه معركة وجودية مصيرية نكون بعدها أو لا نكون، ولكن التغيير يجب أن يبدأ حالا وقبل فوات الأوان.