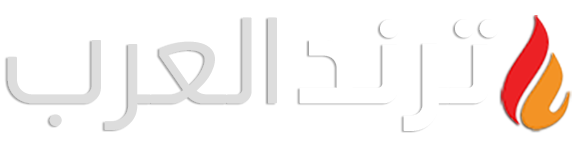جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
أما عن التحققات البشرية والفردية الكبرى، فهى فى مجال تعريفها اليسير الإنسانى فهى حيز من الأفكار المبدعة المتجددة والمتطورة والتى يمكن أن يمضى بها الأفراد أو مؤسسة أو مجتمع ما بثقة وأمل معا ما نحو المستقبل تفاعلا ومنجزا، عملا وسعيا، وهى تتأسس راسخة على بعض ما يحمله تاريخ المضى قدما فى مسيرة الحياة سنوات وقرونا، والتى عبرت عن نفسها فى فعل حضارى وثقافى تشكل عبر الزمان وثبتت فائدته وقيمته تاريخيا لكنه لايكفى وحده لمنح الجديد مستقبليا، بتلك الضفيرة المتداخلة معا يمكن أن تلمح ضياءات التحققات وبلوغ ما كان يعتقد أنه من صعب الأمنيات أو يبدو مفارقا وبعيدا، وحيث لابد أن يشكل ذلك خروجا عن إعادة السير فى الطرائق القديمة إبنة زمانها، والتى مهما بدت ممهدة ومألوفة فإنها غير ذات صلة ولا ارتباط يمكن إثباته بهدف التحققات الكبير فرديا ومؤسسيا ومجتمعيا، وحيث هى ذاتها فى يسرها ذلك تمضى لتفضى إلى نفسها ثانية بلا جديد، هكذا نعرف تاريخ التحقق الكبير وتتشكل منظومة وساحات التطوير واستشراف عتبات الإنجاز المبهر لدى كل شخص وفى أى مؤسسة أو مجتمع.
إنها فى جوهرها ثقافة عمل تؤكد على قيمة التتبع المعرفى لما تحقق والإضافة الإبداعية وتوظيف منجز ومتحقق العلم وخبراته المفيدة، ورعاية الإنسان كيانا وحضورا ومقاما فتتشكل بنية وعصبا لكل جهد مطور وناقل للأمام، شئ كثير من كل ذلك نحتاجه ملحا أيضا فى ثقافة حوارنا الشخصى والمجتمعى بل وتفاعلنا الكونى مع ثقافات العالم، أن تؤسس على معلومات ومعارف وخبرات وليست أنماطا ذهنية سالفة التكوين وغير طازجة الإعداد، وحتى تكون مفضية إلى نتائج مهمة ذات أثر لا تشهد التفافات وتصنع اختلافات تم مناقشتها وإرساء قواعد إدارتها سابقا، ولا تتضمن إعادة تأسيس لبديهيات المتعارف عليه، وحيث المعنى المتفق عليه هنا يصير رؤى مؤسس لها عبر مراحل متدرجة أو مايسمى بنقطة بدء مناسبة، تمنع جدليات القول استمرارا.
ماسبق يمكن أن يفسر كثيرا من الأشياء التى تحدث فى إدارة وتطوير منظومات علاقاتنا الاجتماعية والمؤسسية وربما بعض جوانب حياتنا الشخصية من مشكلات قد تفضى بطرائق حلها الثابتة والمعهودة إلى تكرس حالة إدمان وشغف بمفهوم البدء من جديد فى كل شئ، يصحبه عدم إعتناء بالبناء على ما تم أو ثبتت قيمته مقدرا أو ماهو محل توافق مؤسسى ومجتمعى سابق، فنعيد دائما فض أختام المتفق عليه للإنشغال به عن حل المعاصر واستشراف المستقبل أملا، فنغرق فى الماضوية سلوكا وممارسة وإن كنا نبدو عصريين، يصحب ذلك “نوستالجيا” تستعذب البقاء فى أبخرة زمانها وقد يطلق عليها البعض تعبيرا روامانسيا مفارقا هو الحنين.
سيكون هذا مدخلا لنفهم كيف تظل بعض مشكلاتنا الشخصية والحياتية مؤجلة أو مستمرة إلا قليلا، من دون أن ندرك أن طريقتنا فى التعامل معها على هذا النحو المعهود إنما يمد فى أعمارها كأننا – دون أن نعى – نستهدف ذلك دون غيره، وحيث كل شئ يبدأ من جديد فيتوالى تضييع المسافات عبر الزمن.
ترتبك طريقة التحققات الفردية والمؤسسية وتدفقات خريطتها بطريقتين، إدمان النظر فى التفاصيل أو إهمال النظر فيها تماما، كلاهما شبيهان ومؤديان الى طريق عدم قطع المسافات إنجازا، فإمعان النظر ثباتا ثم المكوث عند جدران التفاصيل وحدها هو عائق عن التطوير سيستغرق كل يوم فى العادى والمكرر ويستنزف الجهد، وسيدخل الفرد مساحة الألفة مع الروتين ولتصحو ذات يوم لتجد أنه ليس هناك فى العمر أو فى المكانة بقية للنظر فى شئ آخر، فتستعذب أن تستمر فى طريقتك “المعهودة” التى عرفتها مستمعا إلى حكمة مسترخية :”اللى جاى يبقى يفكر” وهكذا تلعب دورا فى ترسيخ مرتكزات الثبات والجمود لتقوى عبر الزمن ضد التطوير، ولأنك هكذا ستمهد الطريق لشبيهك فى التفكير – وربما أقل- جريا على فكرة تواصل الأجيال ذات التماثل والألفة، فتستمر طريقة النظر والإدارة والحياة فرديا ومؤسسيا على حالها.
أيضا فإن تجاهل التفاصيل يحرم من واقعية الحلول وإدارة معوقاتها فى بيئات لها تقاليدها وتراثها، وهو شئ يشبه نظرة الشخص العشوائى للحياة، حيث يرى أنه وبالشطارة والفهلوة وبعض من النصيب الذى قد يصيب – ربما بنسبة واحد فى المليون – وبفعل الصدفة وما يراه واثقا وحده من دعاء الوالدين سيتحقق المراد.
إن غياب دراسة البعد الإقتصادى والسياسى والمجتمعى والثقافى لكل شأن وقضية يخل بطرق إدارتها والتعامل معها ويطيل من عمر أزمتها، واستيعاب ذلك يطرح سيناريوهات علاجها يسيرة متنوعة وذات توافق ويقرب من طرق حلها.
تحتاج الحياة – كل حياة – الى رؤية أوسع كثيرا مما تعارفنا عليه وثبت دليلا ماضويا فى تعاملنا مع مشكلاتها وأزماتها وأشجع كثيرا مما نلتزم به يسرا واعتيادا، هكذا ربما تحدث التحولات الكبرى فى حياة الفرد والمؤسسات فتأتى الحلول.