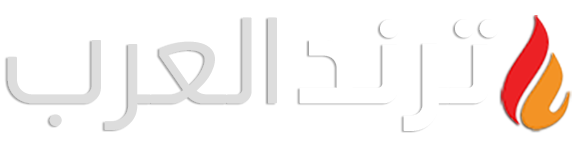جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
تتغير أساليب عيش الناس مع كل تحول تقني كبير، فقد صنع دخول الكهرباء شيئا مختلفا في الحياة عما كان قبلها؛ حيث يسر الكثير مما نعيشه الآن من المخترعات والتي بدورها صنعت تحولات جديدة في أنماط سلوك البشر، وكذلك صنعت بيئة الإنترنت منذ أن عرفها الإنسان، ثم لتنشأ مع الوقت وتنمو وسائل التواصل الاجتماعي، والتي هي سجل الحياة الجديد وديوان سيرتها الأبقى، يواصل منح إتاحات أوسع لشغف البشر كما اختبروه في الزمان القديم بتسجيل وقائع تواريخهم نقوشا على الحجر والجلود وعظام الحيوانات، داخل الكهوف أو نحتا في الجبال، ثم صاروا الآن صنع كل منهم سجل تاريخه وسيرته الذاتية المروية بنفسه وقائع يومية ينثرها حضورا نصا وصورا وفيديوهات مع ما تيسر من تعليقات ولايكات وإيموشنات وهكذا يمضي تاريخ السرد.
قد يمضي المرء ويبقي ما سرده على وسائل التواصل الاجتماعي حيا لمن أراد إليه سبيلا، تلك الصور في الأماكن ومع الناس ورأي الشخص فيما عرف واختبره أو سمع عنه، صدقه وادعائه، تزلفه ومخاصمته، هو سجل عما جري، نحن هنا حقا أمام عشرات الملايين من الروايات المختلفة في دقتها ومرجعياتها وأسباب وتوقيتات طرحها عن أحداث وأشياء وبشر العالم، فهل حمل التاريخ يوما أو حظي البشر بمنحة كهذه أبدا؟!.
وبينما يقول المؤرخون إن كل كتابة للتاريخ تحمل أثرا من صاحبها ورؤيته وتحيزاته، فإنه لا تحتاج وسائل التواصل الاجتماعي إلى مثل تلك العبارات البليغة والمقدمات المدهشة هي تفعلها وفقط، حيث كل بروفايل وكل لقطة أو كتابة هي صاحبها في توقيت ما، وكل صورة هي ما اختاره ليظهر أو يحضر أو يبقي، كما أن كل تويته هي إحالة لفضاء وسياق ودلالة عن موقف وحالة، وهي قول في التاريخ الشخصي والجمعي لسكان كوكب الإنترنت الذي يسع مجرات لا تحتاج سفرا أو سرعة صوت أو سفائن قادرة على تحمل فقدان الجاذبية الأرضية.
لا يُقصر فضاء تلك الوسائط في منح عاطفة ميزت تاريخ الإنسان، فهو ليس جامد القلب متحجر الشعور، فاللايك هو عطف سيبراني متعارف عليه، تزينه القوب والألوان وما يستجد، حتى ليبدو من صدق القول أنه من يعش بغير اللايك في مستقبل الأزمان فسوف يمضي في الحياة وكوكبها محروما وحيدا.
والصداقة عبر وسائل التواصل تبدو من وجهة النظر المجردة صداقة عصرية أنيقة، تزيل كل إرهاق وتبعات الآف الأمثلة التي حملها تاريخ الناس عن غدر الأصدقاء، فهي تتتحلي بخبرات التاريخ فلا تتيح تورطا في القول أو في القرب كما أنها تنتهي وتستعاد بضغطة واحدة، وهكذا يتكون مجتمع الأصدقاء يسيرا ويمضي متضخما مع كل مرة “accept” ويتم فرزها مع مضي الحياة بلا ثمة مخاطر إذ تمنحك ضغطة الـ “unfriend” ارتياحا بإقصاء من كان في قائمة الأصدقاء سهوا أو غفلة أو خطأ، بل إنها تمنحك ميزة إضافية بإزالة حضوره ومنحه عزلة إجباريا فلا تراه البتة بضغطة ” block”.
ومع كل بلوك يمكنك أن تغلق دائرة الاختلاف من حولك وتوسع من مساحة تكرار ما تحب أو ترغب في الاستماع له أو باختصار فيوضات نفسك إذ يعبر عنها من من منحتهم حق البقاء الآمن تحت مسمى “فريندز”.
تتفنن وسائل التواصل الاجتماعي تلك في الجمع في يسر بين طرفي الرغبات والاحتياجات البشرية، وتيسر ذلك فتصنع العادات وترسخها، ومن ثم يكون الحديث الدائر والدعوات العابرة بمخاصمة الفيس بوك والاستمتاع بالعودة إلى الحياة الطبيعية والقرب الدافئ وحرارة ملامسة ومصافحة الأيدي والتقاط الكلمات من الأفواه ليست سوى مزيد من تأكيد على الضعف حيالها، وعدم القدرة على الاستغناء عن عالم هو يشبهك ويُصنع على عينك ويضم ما تعرف، بل هو يسبقك طائعا فيلبي تفضيلاتك، فمنذ أن تفتح رابطا أو تشاهد فيديو ما إلا وستكون خوارزمياته قد قرأت خريطة تفضيلاتك وإتاحة ما يشبهه لك، لتجدها ظاهرة مع كل تصفح وكما لا يستطيع أن يفعل مثلا ذلك عفريت الفانوس السحري، وأيضا بغير مشقة الاستماع إلى “شبيك لبيك”.
يصنع البشر في مسارات الحياة تيسيرات البقاء، أشياء تبدأ بسيطة وربما مفيدة، ثم تنفصل عنهم رويدا ليكونوا هم داخل دائرتها، هذا هو تاريخ الإعتياد، يبقى أنه لم يتم دراستها ثقافيا واجتماعيا، بمعنى دراسة أشكال الحياة وظواهرها كما تسردها برديات الفيس بوك وحوائط إنستجرام ومفردات تويتر، دراسة الحياة على تلك الوسائط لا تقل شأنا أبدا عن دراسة الواقع، فتلك آثارنا باقية على فيس وتويتر وانستجرام تدل علينا.