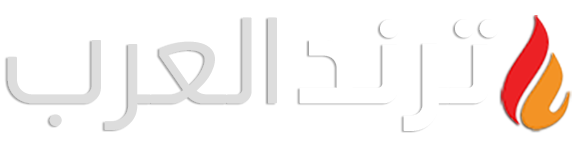ولم يكن غاية الحداثة هدم الأديان، بقدر ما كانت محاولة لحماية الممارسة الدينية باعتبارها تجربة فردية روحية، وإشراع أبواب التأمل والمراجعات حول قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية وطرح ما يمكن تسميته عقلنة التصورات الدينية، تفادياً لمعطيات الإسفاف والاستخفاف في الحد الأدنى، وتحاشياً للمبالغات والأسطرة في المستوى الأعلى.
حاربت الأصولية الحداثة، كونها ترفض تسخير الدِّين للسيطرة السياسية، وخشيت منافستها في استقطاب الجماهير، فلجأت للتشويه، ونعتت أهلها بالسقوط الأخلاقي، والانهيار السلوكي، بينما في التراث «لا تؤدبوا أولادكم بأخلاقكم، لأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم»، ومعطيات الحداثة تخلق انسجاماً مع الواقع لكي لا نتوقف ولا ننكص للخلف، ولا نبالغ في استشراف المستقبل بأدوات بدائية. ويرى المفكر المغربي محمد سبيلا أن تشنيع بعض الباحثين على الحداثة، كونها تتعارض مع الأخلاق، طرح غير موضوعي، كون للحداثة أخلاقها، إلا أنها أخلاق تختلف عن الفهم التقليدي لمعايير ومرجعية الأخلاق، فلا تعوّل على أخلاق الضمير الفردي ولا تكتفي به باعتبار الضمير لا يحول دون انتهاك الضوابط الأخلاقية، خصوصاً في زمن الوفرة والاستهلاك والانفتاح على الملذات والمتعة (أنواع الزيجات) المشرعنة نموذجاً.
ويؤكد سبيلا أن الأخلاق الحداثية تقوم على الحد من التجاوزات بالقوانين والأنظمة المؤسسية، وإعلاء شأن الحقوق، والالتزام بالواجبات، لافتاً إلى أن بطء التحوّل من أخلاق الضمير إلى أخلاق المسؤولية يوحي بالتسيّب وعدم النشازات الناشئة عن عبثية أجيال لا تفرق بين الحُريّة بمعناها السامي وبين التصرفات التحررية المنفلتة.