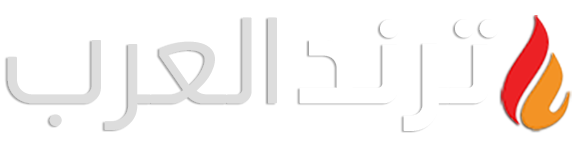من أسرار جمال هذا الفيلم، أنه يرصد واقع المجتمع كل عام، وما يتعرض له من اضطهاد، ثم يختار نموذجاً ليسلط الضوء عليه، وكأننا أمام حدث يتكرر مع نهاية فصل الربيع من كل عام، ففي السابع والعشرين من مايو، كانت ذكرى ميلاد وموت الروائي ” أدهم سليمان ” الشخصية الرئيسية في الفيلم، الذي يلقى حتفه منتحراً.. وبنفس التاريخ، تنتحر “عواطف” زوجته أو ترغَم على الانتحار.
” أدهم ” من الشخصيات النرجسية المنتحلة ،المبتكرة فنون اصطياد ضحاياها ، فهي تدرك كيف تمتص رحيقهم وتسرق أحلام الحالمين، بعد أن تستعبدهم وتجردهم من أي قيمة إنسانية ، وتحولهم إلى دُمىً تشكلها بأصابعها ثم تعزلها عن الكون، وفي نهاية المطاف يتخلصون منها ويجعلونها وقوداً للسعير، “فأدهم “رمز السلطة النرجسية الفاسدة التي لا تبصر إلا نفسها، وزوجته “عواطف” ترمز للشعب الذي يحلم بغد أفضل ويركض وراء حلمه بالبحث عن الحب والأمان والاستقرار النفسي، فيشوهون حياته ويزرعون بداخله الخوف ويوهمونه بأنهم باب النجاة حتى يبقى تحت القبعة يخضع لوصاياتهم . تعتمد السينما على فن الابتكار وحرفية الصانع في بناء السيناريو، كما تحتاج لمخرج مثقف واعٍ يمتلك المعرفة، فيهب الحياة للأوراق التي بين يديه من خلال رؤية بصرية وفنية ناضجة يقدمها للمشاهد فتسحره وتشوّقه وتمنحه متعة ومعرفة، فيتابع ما يدور على الشاشة ويتفاعل مع الحدث حتى يصبح جزءًا منه. وأكبر برهان على ذلك تجربة المخرج “مصطفى مراد” والتي تعد تجربة رائدة من نوعها، وتستحق تسليط الضوء عليها، والسر هنا يكمن بأن عملية البناء للسيناريو كانت تفتقد لسمة رئيسة وأساسية في صناعة الفيلم، وهي الفكرة المبتكرة التي تساهم في بناء سيناريو يجذب المنتجين لإنتاج مثل هذه الأعمال. وهنا يزداد التعقيد في صناعة هذا العمل وتظهر المعرفة وقدرة المخرج على فن الإقناع، فكما قلنا سابقا السيناريست لم يتناول فكرة جديدة ابتكرها، بل تناول فكرة مستهلَكة شاهدناها في العديد من الأفلام والمسلسلات العربية والعالمية. ومع ذلك، ولكون المخرج هو أيضا كاتب السيناريو، استطاع أن يعالجه بروح جديدة وأسلوب مميز جعلنا نتابع الحدث بانسياب، وكأنني أمام سيمفونية بصرية رسمت لوحات جميلة المضمون تسرد واقع الشارع والطبقة الانتهازية المستغلة ، فكل العناصر التي أسهمت في بناء السيناريو والإخراج ، قدمت لنا فيلما مميزا بصريا وفكريا ويسير بإيقاع متناسق يجذب المشاهد، فحرفية هذا السيناريو بثقافة كاتبه ووعيه ومتابعته لما يدور حوله من تجارب الآخرين كنموذج “مسلسل أفراح القبة “، والاستفادة من أدواتها لنسج حكايته بأسلوب مشوق وبطريقته الخاصة ، فمن يشاهد هذا العمل سيدرك أن المخرج الكاتب / مصطفى مراد جمع ما بين فن المسرح والسينما بجمالهما ،كما قدما لنا شخصية متناقضة ما بين الماضي والحاضر بأسلوب فني راقي يعتمد على الميلودراما وأسلوب مسرح بريخت ، كما استعرض لنا الشارع المصري والواقع الاقتصادي المنهك للمواطن من خلال نماذج مختلفة رصدتها الكاميرا.
فشخصية “أدهم الكبير” والذي يمثل الحاضر، أتقن الدور الفنان ” أحمد عباس ” حيث قدّم لنا شخصية مستسلمة، تعيش عقدة الذنب تكره الماضي، تحاول التحرر من الأنا والجرائم التي اقترفها وأصبحت لعنة تطارده طيلة تجربته الحياتية، رغم محاولته المتكررة ونسج صور من مخيلته لتغيير الماضي وتحسينه إلا أنه يفشل.
“أدهم الشاب” الذي يمثل الماضي، قام بأداء الشخصية الفنان الجميل المبدع التلقائي” أحمد عادل ” فالشخصية نرجسية، مريضة انتهازية تستعبدها الأنا وتجردها من القيمة الأخلاقية، فلا يرى ولا يحب إلا نفسه، فالعالم بالنسبة له دُمىً يحركها من أجل أن يكون بطلا اسطوريا يشار له بالبنان.
“عواطف”.. الفتاة الرومانسية الحالمة، تعشق الموسيقي، لا تشعر بالاستقرار النفسي مع زوجها، تحاول أن تتعايش مع الواقع، رغم شعورها بالتهميش وما يسيطر عليها من حزن ووحدة، قامت بهذا الدور الفنانة الواعدة ” ساندرا سامح “، عاشت تفاصيل الحكاية بكل جوارحها، وأحيانا كانت انفعالاتها زائدة، أكثر من الطبيعي للتعبير عن الشخصية.
السائق.. قام بدوره الفنان ” عاصم السعدي ” الذي يمثل جيل الشاب الضائع المغيّب الذي يعيش فوضى الحياة، فيتكيف مع أي مغيبات تبعده عن الواقع، كأغاني المهرجانات التي تفتقد للمعني والجمال.. فهي نوع من أنواع المخدِّرات التي تغدر بالذوق العام للمجتمع وبتلقائية قدم لنا شخصية جميلة تعبر عن ضياع الشباب.
الفنان ” ناصف صالح ” قام بدور البواب.. رغم تقمصه للشخصية واندماجه إلا أنه أحيانا كانت تظهر انفعالاته أكثر من اللازم، فيوحى للمشاهد أنه يمثل الشخصية، الطفلة الجميلة الواعدة “هاجر أحمد ” قدمت دور شيماء.. فعبرت هي والفنان ناصف عن شريحة الطبقة العاملة التي تجتهد للحصول على قوت يومها. شاهدنا الشارع المصري من خلال مشهد السيارة التي يستقلها “أدهم” أثناء عودته لبيته الذي هجره منذ ثلاثين عاماً، فنرصد واقع المجتمع المضطَهد الفقير الذي يفتقد الابتسامة.
هذه الأدوات الفنية أسهمت بآلية بناء سيناريو مترابط قوي، فأنتج فيلما ناضجا فنياً، فمنذ اللحظة الأولى للعمل، نرى الوجوه البائسة التي لا تبتسم.. ونبصر الواقع الاقتصادي المزرى من خلال الشخصية الرئيسية “أدهم ” ابن الحاضر الذي يقدمه المخرج وهو يعيش حالة اغتراب بينه وبين المكان والزمان والمجتمع. يشعر بالدونية وعقدة الذنب بعد انتحار زوجته أو بالأصح قتلها معنويا ثم جسدياَ ببرود أعصاب قبل ثلاثين عاما ما جعله يترك البيت ويختفي عن الأنظار.
نحن أمام مخرج يمتلك أدواته بحرفية عالية ويدرك طبيعة البعد النفسي لزوايا الكاميرا التي يختارها، فيصنع من أحجام لقطاته وتنوعها موسيقي إيقاعية متجانسة ولوحات فنية معبرة.
يبدأ فيلم “السابع والعشرون من مايو” على شاشة BLACK ونسمع طرقات مرعبة على الباب وصوتا منفعلا ينادي بفزع “أدهم، أدهم، افتح يا أدهم!”. يعلو الصوت تدريجياً.. يجتهد المخرج بالثواني الأولى فيخطف انتباه المشاهد ويوجهه إلى حدث مهم سيحدث وعليه ترقبه، بعد ذلك تظهر الصورة تدريجيا Fade In على لقطة عامة Long shot لرجل يقف محايدا في منتصف الكاد، تقطع الكادر من أمامه سيارة حمراء اللون، مرور هذه العربة لها رمزيتها، فالدلالات التعبيرية للألوان التي استخدمها المخرج تسهم في البناء وفي جماليات التكوين، وتشرح الحالة وتعرّفنا على ملامح الشخصية والخطر الذي يلتف حولها.. ” فأدهم ” الذي يمثل الحاضر ويظهر في منتصف الكادر في أول لقطة Long shot نراه يقف محايدا يلتفت يمينا ويسارا يترقب شيئا ما، يقطع المخرج على لقطة medium shot فتظهر انفعالاته بشكل واضح، حيث يعيش حالة صراع داخلي، يستمر الحدث ويعود حجم اللقطة Long shot، فنشاهد “أدهم ” يلتفت حوله حتى تقف سيارة ويترجل منها الشاب “عاصم السعدي ” الذي يقوم بدور السائق، يعتذر لأدهم ويقول له إن سبب تأخيره قيامه بتوصيل جماعة للمطار. وهنا يرصد لنا واقع الحياة الاقتصادية البائس. من خلال كلام السائق تتضح الصورة ” أصل اليومين دول الدنيا نشفه ” ثم يحمل حقائب أدهم ويعتلي سيارته و يفتح التسجيل ويعلو صوته، فينسجم السائق الشاب مع الأغنية ويدق بيديه وكأنه مغيّب يهرب من الواقع ، تسير السيارة في الشارع فنشاهد لقطات متنوعه ومتناسقة تسير بانسيابية تعبر عن المجتمع المصري الموجوع، يبدأ “أدهم الكبير” بالاعتراف ليتطهر من ذنوبه ويعترف بخطاياه فيقول : “ربما تكون هذه فرصتي الأخيرة ، ربما أستطيع ، ربما أفشل، ولكن حتما سأدرك الحقيقة ،محكوم أنا بالعودة “، أثناء الحوار الذي يسرده أدهم( آخذني رهينة الوصول )”يمر كلب يلهث ” ، واللقطة هنا تعبر عن حالته النفسية والضياع ” لذا سأصل حاملا حقائبي مرتديا بنطالاً بلا لون وحذاء يشبهني، ولرمزية الحذاء المهترئ ، المتهالك القديم وعلاقته بالأرض يظهر أن هذا الرجل يحمل كل القاذورات ، يفتقد للمشاعر، غير قادر على العطاء ولا ينتمي إلا للانهزام، وبناءً على النص السابق الذي تلاه ووجود الوجوه الشاحبة المقهورة والكلب الذي يلهث، عندما سرد أدهم نص ” آخذني رهينة الوصول ” واعترافاته بأنه مهترئ من الداخل ويلبس حذاء يشبهه ولقطة Tilt down على البيت الذي عاد إليه وانتهاء اللقطة بتقزيمه أمام شموخ البيت، ليقول المخرج إن هذا الرجل ضعيف أمام جبروت هذا المكان وما يحمله من تاريخ رغم ما تعرّض له من تعرية. فرغم أن البيت من الخارج متآكل ومدخله مكدس فوق عدادات الكهرباء بالغبار ، إلا أننا نرى “أدهم الكبير” يتفحص المكان بشغف ، تنقطع صلته بمن حوله فيواصل البواب الكلام والحديث عن اختفائه وما كان يدور حوله أثناء غيابه، وأدهم خارج السياق، يغرق بصمته ويمارس غيابه عن الواقع ،وأثناء صعود الدرج يأخذ المخرج زاوية High Angle فيظهر الدرج على شكل متاهة و يظهر أدهم والبواب كشخصين مستضعفين ، تتوالي الحركة ونرى أدهم يعيش حالة التيه والتهميش والاغتراب ، يقف أمام باب بيته مغيبا ، يحدثه البواب دون أن ينتبه أو يسمع ، يثرثر البواب ويثرثر ، وأدهم لا يدرك ما يدور حوله ، يُخرج محفظته ويشاهد صورة زوجته “عواطف” المنتحرة بشكل كلاسيكي بناء على ما كتب بالصحف والمقتولة بشكل فعلي ومعنوي أكثر من مرة بفعله ، فهو لص سرق حياتها واستهتر بمشاعرها وبقدرتها الفنية وعزفها على الهارمونيكا وقال لها ألعبي بالزمارة ..واليوم سيعود للماضي بما يحمله من عذابات ، يخرج مفتاح البيت فترتعش يداه ، كأنه يفتح قبره، وينقطع اتصاله بالمكان والزمان ، فيعتقد البواب أنه فقد عقله عندما استرجع ذكرى انتحار زوجته أو توجيهها للانتحار، فيقول له البواب” الله يكون بعونك “. استعرض الكاتب المخرج مكونات العمل.. المكان وملامحه الجغرافية والزمان الحالي والشخصيات وواقع المجتمع وعناصر تسلسل القصة التي تتكرر كل عام مع
شرائح مختلفة من المجتمع رغم اختلاف اللاعبين، قبل أن يصل البيت ويمسرح لنا الحكاية المراد تسليط الضوء عليها.
عُرض لنا البيت من الداخل وما تعرّض له من تعرية، فعلى الجدران تنتشر خيوط العنكبوت.
الديكور، الإكسسوارات، الأغاني القديمة، الملابس والماكياج، كل هذه العناصر استعرضت لنا الماضي بكل تفاصيله وجعلتنا جزءا منه. فالماضي داخل البيت والحاضر هو خارج البيت بكل ملامحه
اعتمد المخرج على الضوء الطبيعي ليحد من عتمة الماضي، عندما فتح “أدهم الكبير” باب بيته المتهالك التي تغزوه العتمة وخيوط العنكبوت ، طاف في أركان البيت بنظرته المحايدة، وفتح الشباّك ليكتشف أن الحياة تغيرت من حوله وتكدست أمامه حجارة صامتة بيضاء، تدل على الجمود، كما أوحى للمشاهد أنه جسد ميت ، دُمي متحركة ، وبيته مقبرته تحمل أسرار الماضي وعفنه ، خيوط العنكبوت ، المسجل والأغاني القديمة والأشرطة ، المياه الصدئة العكرة التي تنزل من الدش أثناء استحمامه ، جميع المفردات تعبّر عن موت مؤجل ،كما مزج الماضي بما يحمله من وجع بالحاضر من خلال شخصية “أدهم الكبير” الذي يستعيد من الذاكرة حكايته مع زوجته عواطف فنراه بعد الاستحمام بالماء العكر يجلس يدخن سيجارته ويستمع لغناء “عبد الوهاب ” ..امتى الزمان يسمح يا جميل ” يسترجع الماضي ويفتش بين الصور عن الذكريات، وما كتب بالصحف عن انتحار زوجته ، ثم من وراء الكواليس ينقلنا للحدث فنصغي لغناء الفنانة عفاف شعيب ” أحلم ببكرا يجينا ،عيني يا عيني، منى عيني “. يعتمد المخرج في بناء عمله على أسلوب التناقض. فمضمون الأغاني يختلف عن مشاعر الشخصية إن كان بأغنية ” أمتي الزمان أو أحلم ببكرا ” وعلى مسرح الميلودراما. “فأدهم الكبير” ينسج المشهد من مخيلته فيتبع صوت الغناء ويمر من تحت إضاءة دائرية حمراء مسلطة على مدخل الحدث وكأننا على خشبة مسرح ،ينظر الحاضر إلى الماضي من وراء الكواليس ،فنشاهد الفنانة ” ساندرا سامح ” “عواطف ” تحاول إسعاد نفسها أثناء تجهيز الطعام لزوجها فترقص وتغني مع صوت الفنانة عفاف شعيب، وعندما يأتي زوجها “أدهم الشاب ” النرجسي المريض الذي تسيطر عليه رغبة التملك ويتعامل مع الناس على أنهم دمى تواصل الرقص معه ثم يطلب منها أن تأتيه بالطعام بعد أن يذهب، تقف ثواني تنظر للكاميرا بملامح مثقلة بالهموم وكأنها تريد أن تنقل للعالم وجعها ورفضها لواقعها ، وأثناء تناول الطعام يدور الحديث عن روايته وإلى أين وصل بها فيقول لها ” أنت عارفة أول مرة بحس إنه الصور بتهرب مني، كأنه الأشخاص أو الحدوتة رافضين وجودي ” وأثناء خروجه يحاول التسخيف منها عندما يقول لها ” أنت ألعبي بالزمارة بتعتك”.. فتغضب “عواطف” مستهجنة أسلوبه وتقول “زمارة.. دي اسمها هارمونيكا “.
بعد ذلك نشاهد الماضي المتمثل بأدهم الكبير يجلس مع عواطف ثم ينظر للمرآه المهترئة، فيرى القبح الذي يستوطنه متمثلا بالخطوط السوداء التي تغطي الجانب الأكبر من شخصيته في المرآة، فتأتي عواطف بقميص النوم الأبيض فيسترجع الماضي وهو يقول لها إنه تعبان من موضوع الرواية، ليكتشف المشاهد عندما يعودون للماضي، أنها مجرد دمية امتلكها بسبب غيرته من صديقه ثم تم استغلالها من أجل مآربَ شخصية والبحث عن الشهرة، “عواطف” بالنسبة له مجرد موضوع للرواية. ففي اللحظة التي شاهدها تعزف وعلم أنها تحب صديقه وستكون زوجته، لفتت انتباهه وقرر أن يمتلكها كأي دمية لتكون لعبته. وهنا بدأ برسم خطته، فهو يعلم أن صديقه يعمل بالسياسة، فقرر أن يبلّغ عنه الأمن، واتفق مع الضابط أن يصرح أمام الجميع أن “عواطف” هي من وشت عن حبيبها وبهذا تهتز شخصيتها وتستسلم لما سيحدث بعد ذلك، يتقدم “أدهم ” لخطبتها كبطل أسطوري لينقذها وبهذا يصنع من تجربته معها روايته التي ستمنحه الشهرة، بعد أن يصب عليها ألوان القمع، ويعزلها عن مجتمعها ويحرمها من مواهبها.
يحاول “أدهم الكبير” ابن الحاضر أن يعدّل أسلوب أدهم الماضي، في محاولة منه لمحاسبة نفسه والتكفير عن ذنوبه وما اقترفه بحق “عواطف “فيبدأ “أدهم الكبير” يقترب من عواطف ويتفاعل مع أنغام الهارمونيكا، ينسجم مع عزفها ثم يفضفض عن نفسه ويخبرها عن الصراع النفسي وحالة التناقض التي تصاحبه.. فيقول لها “لو بتعرفي أد إيه أنا بحبك ، على أد كرهه ليكي، على اد ما بحبك” فتسأله عواطف “مين هو اللي بيكرهني “فيرد عليها “هو نفسه اللي بيكرهني ” وتعود للسؤال “ومين دا اللي بيكرهك ” فيجيب ” أدهم”، وهنا نشعر بازدواجية الشخصية الذي يعيشها “أدهم الكبير” والنرجسية التي كان تسيطر عليه في مرحلة الشباب ،فهو مجرد من المشاعر، يحاول قمع زوجته كي يصنع حدثا يأخذه للشهرة والأضواء والحديث عنه في الصحف وفي وسائل الإعلام ، فنراه يصر على تذنيبها في كل لحظة يتوفر له ذلك ليطمس شخصيتها، فعندما تقول له بعد الاستهتار بها وبعزفها، أنه تعرّف عليها وهي تعزف على الهارمونيكا ، يعيد شريط الماضي وبحقد يتهمها بعلاقة غرامية مع صديقه ” عرفتك لما كنت معاه لما كنتوا سوى بتعزفوا بالجامعة ،سمير لطفي ،حبيبك الولهان” ثم يحاول التشويه على صديقه سمير لطفي ، فيقول ” اسمها غار في ستين داهية ، لما كان راح يخرب البلد، اتسجن ، ولما خرج رماك وما سألش فيك ” ، محاولة متكررة منه لكسر شخصيتها حتى يحبطها ويجعلها تستسلم للأمر الواقع ويجعل من نفسه بطلا خارقاً، فتأتي شخصية الحاضر لتعدل مسلكية الماضي وتبرئة نفسه من الأحقاد ” غلط أنت غلط ، أنت جواك أبيض يا واد ، أنت عارف أنها بتحبك ، ما تبقاش حمار ، قلها ما تزعليش مني ،أنا حمار”.. تتوالى الأحداث ونشاهد “أدهم الحاضر” يخرج فستان الفرح ليعيدنا للماضي وكيف كان يستغل زوجته لبناء الشخصية بالرواية، فيطلب منها أن تلبس فستان الفرح بعد سنتين من زواجهما وبعد الانتهاء من الفصل الأخير من كتابة الرواية، أعترف لنفسه بأنه لم يحبها وكل ما حدث، هو مجرد الرغبة في الاستعباد والامتلاك، فعواطف بالنسبة له دمية قطنية وهو كأي طفل يرغبها وعندما يشبع منها سيلقيها. دار صراع نفسي متناقض بين “أدهم الحاضر” و”أدهم الماضي” من أجل تغيير بعض الأحداث في الرواية، فرفض أدهم الماضي التغيير لأن الزمن لا يعود للخلف وللتأكيد استعمل الطاولة كخشبة مسرح حيث صعد عليها، بعد أن سلطت عليه إضاءة دائرية من فوق فظهر نصف وجه معتما ونصف مضيء تعبيرا عن الازدواجية في الشخصية وعندما جلس القرفصاء على الطاولة كان وجهه مظلما ليقول المخرج إننا وصلنا النهايات ولن تكون هناك أي محاولة للتغيير. فهو خان صديقه الأوحد “سمير لطفي “وقتل زوجته أكثر من مرة معنويا قبل أن يقتلها جسدياً فيقول أدهم: بعد نشوة الامتلاك إنه فقد الإحساس بها تدريجيا، يبدو أنه لم يحبها، كانت بالنسبة له دمية.
” بعد انتهاء أدهم من كتابة الرواية، تقرؤها عواطف وتكتشف أنها ضحية رجل نرجسي يلعب بالبيضة والحجر وبحنكته استغل الجميع وسخّرهم لمآربه. فتصارحه بحقيقته، فيتعامل معها ببرود وكأن شيئا لم يحدث ويقول لها بسخرية ” لطالما حاول أدهم إخفاء الحقيقة، لطالما حاول أدهم خلق حقيقته الخاصة ” ليؤكد لها على تزييف واقعه حسبما يريد ثم يحاصرها ليتخلص من دميته بعد أن شبع من اللعب بها، ليؤهل المشاهد للنهايات بعد أن يفتح لها أبواب الموت، كان يبتسم وهي تهمس ” أنا بكرهك” حتى رحلت اختفت عن الحياة. وفي نهاية المطاف يكتشف أدهم أن الذنوب لا تسقط بالتقادم وأن الماضي لن يعود والهروب والسفر لن يطهراه من الداخل، لذا يقرر الانتحار، يوم مولده وموتها، تكفيرا عن سيئاته ، فملأ البانيو بالماء وجلس مسترخيا يدخن ثم حلق ذقنه و لبس أجمل الثياب و أحضر أنبوبة الغاز وهو يجرها واختفى أدهم الحاضر وظهر ” أدهم الشاب ” فوق السرير ،ليقول أدهم الكبير الذي عاش التجربة ،الهدف من الانتحار ،قتل هذه الشخصية الآثمة التي استحلّت شبابه وجعلته عبداً ” ربما أكون عاجزا على خلق حقيقة مختلفة ، لكنني حتما قادرا على أن أولد من جديد “.
يفتح أنبوبة الغاز ويستلقي على سريره ويعود أدهم الحاضر منتحرا بذقنه الطويلة وملابسه القديمة فهو جسد ميت منذ البداية ولن يتطهر أو يغتسل من الآثام مهما صنع ، وفي نهاية العمل يأخذنا المخرج لمشهد البداية وطَرقات البواب على الباب وهو يصرخ ” أفتح يا أستاذ أدهم ” .
“السابع والعشرون من مايو” تجربة فنية تتميز بإيقاعها الجميل وحرفية الصانع.
فالممثلون مبدعون متألقون، رغم وجود بعض الانفعالات الزائدة والشحنات العاطفية عند البعض، وقد تحدثت عنه سابقاً. وهناك أيضا ملاحظة على فسيولوجية الشخصية أقصد الشكل الخارجي ” لأدهم الحاضر ” وأدهم الماضي ” فالشخصيتان مختلفتان في الشكل الخارجي ولا يتناسبان مع بعضهما بعضاً.
الإضاءة وُظفت بشكل فني يجسد الحالة الفنية للأبطال، حيث اعتمد المخرج على الإضاءة الطبيعية في الشارع وأحيانا في البيت، إضافة للإضاءة الصناعية المتمثلة بإضاءة المسرح وقد عبرت عن الحالة النفسية للبطل وخاصة عندما اعتلى الطاولة على أنها مسرح وبدأ يخاطب الجمهور وقد سقط سهواً بعض الإضاءة الزائدة على وجه ” أدهم الشاب”.
الموسيقى.. إبداع، مؤلف الموسيقى بالتعبير عن الحالة النفسية لشخصيات العمل وباختياره الأغاني القديمة والحديثة، التي ساهمت بنقل المشاعر الحقيقية لدى المشاهد في الزمانين وتناولت التناقض بين الشخصية والأغنية.
بخصوص المكياج.. أستطاع الماكيير أن يعبر عن الحالة النفسية للجميع بشكل جيد رغم أن هناك بعض المبالغة في الماكياج وكان غير ملائم لشخصية ” عواطف ” أثناء استيقاظها من النوم وبأماكن متفرقة
وأخيرا رغم بعض الهفوات البسيطة إلا أننا أمام عمل جميل ومخرج مبدع وطاقم مهني مميز يستحق أسمى معاني الجمال والتقدير.