اكتسبت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي اهتماماً كبيراً، في ظل الحديث عن تطور العلاقات بين البلدين وبين الصين ودول الخليج والدول العربية. ورغم أهمية هذه الزيارة من منظور تطور وتبلور العلاقات بين المملكة والصين على وجه الخصوص، الا أن تطور العلاقات بين البلدين بدأ منذ سنوات وليس وليد هذه الزيارة، إذ تعود أهمية هذه الزيارة إلى قضيتين، تتعلق الأولى بأهمية المملكة ودورها وتأثيرها على الصعيد الخليجي والعربي، والثانية ترتبط بالتوقيت والتطورات على الساحة الدولية. وقد يفسر غضب الولايات المتحدة من هذه الزيارة والتطورات التعاقدية التي جاءت في سياقها أهميتها.
ولا ينفصل غضب الولايات المتحدة من المملكة هذه المرة عن تطور سابق جاء قبل شهرين يتعلق بموقف المملكة من الطلب الأميركي بزيادة إنتاج النفط في إطار منظمة “أوبك +”، وهو الأمر الذي رفضت المملكة الالتزام به، معتبرةً أن ذلك يعد شأناً يتعلق بالمنظمة نفسها، الأمر الذي جعل الولايات المتحدة تتهم المملكة بالتواطؤ مع روسيا.
والسؤال هنا: هل تشير مواقف المملكة العربية السعودية الأخيرة إلى وجود خطر يواجه نفوذ الولايات المتحدة بين حلفائها في المنطقة؟ أو هل نجحت السياسات الصينية والروسية في بسط نفوذها ومكانتها في المنطقة على حساب الولايات المتحدة؟
تطور العلاقات السعودية الصينية ليس وليد هذه الزيارة، وإنما جاء تدريجياً، وترسخ في ظل سيادة منظومة المنفعة والمصالح المتبادَلة، التي روّجت لها المبادئ الغربية في الأساس، وجاءت بعد انتهاء الحرب الباردة، وتبنتها دول العالم بما فيها الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية والدول العربية وعملت جميعاً في ظلها. وساهمت استراتيجية الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط بالانسحاب منه والاستدارة نحو آسيا لمواجهة الصين، والتي ظهرت منذ عهد الرئيس باراك أوباما، في بلورة دول المنطقة لسياساتها انطلاقاً من مصالحها، وليس لاعتبارات أيديولوجية أو لارتباطات سياسية سابقة.
بدأ التطور التدريجي في علاقة المملكة العربية والصين منذ العام ٢٠٠٣ عندما أصبحت المملكة مورّد النفط الأكبر للصين، وشهدت السنوات التالية محطات مهمة في تطور تلك العلاقة بين البلدين، خصوصاً بعد إطلاق الصين لمبادراتها الحزام والطريق عام ٢٠١٣، في ظل مكانة المملكة الجيوسياسية وثقلها في سوق الطاقة أيضاً الذي تحتاجه الصين بنهم.
وركزت الاتفاقيات الأخيرة بين المملكة والصين، بالاضافة إلى تطوير التجارة بين البلدين، والتي نمت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، تنمية الاستثمار الذي تتطلع اليه المملكة في ضوء خطتها الطموحة الموضوعة لعام ٢٠٣٠. وجاءت الزيارة باتفاقية شراكة استراتيجية، وانفتاح على مشروعات صناعية وتكنولوجية، بما فيها مع شركة هاواوي التي تحارب واشنطن انتشارها. لا يعتبر ذلك موقفاً جديداً للمملكة، ففي عام ٢٠٢٠ ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن المملكة شيدت بمساعدة الصين منشأة لاستخراج الكعكة الصفراء لليورانيوم، وهو ما كانت تمانعه واشنطن.
إن طبيعة وحدود العلاقة بين الصين والسعودية غير مشروطة سمحت بهذا التطور في العلاقة والتي نشهدها اليوم، على عكس النظام المشروط الذي رسخته واشنطن في علاقاتها مع حلفائها العرب، فوضعت على سبيل المثال حدوداً لتسليح الدول العربية العسكري، والذي اقترن بضمان التميز العسكري النوعي لإسرائيل عن باقي دول المنطقة. إن ذلك يفسر لجوء المملكة إلى الصين للحصول على أسلحة لم تسمح لها واشنطن باقتنائها، وتضاعفت صفقات شراء السلاح الصيني من قبل المملكة خلال السنوات الاخيرة مئات المرات مقارنة بالعقد الماضي.
ولا تختلف ملابسات تطور العلاقات السعودية الصينية عن تلك التي صاحبت تطور العلاقات السعودية الروسية أيضاً، التي تعد مثالاً آخر على تطور علاقات هذين القطبين الصاعدين مع دول المنطقة ومناطق أخرى من العالم. فرغم تاريخ طويل من التباين الايديولوجي والسياسي، تطورت علاقات المملكة العربية السعودية مع روسيا، حيث يمكن رصد بداية ذلك التطور في العام ٢٠١٥، عندما التقى الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي، وقع على أثره عدد من الاتفاقات شملت مجالات عديدة منها الطاقة النووية، وتفعيل اللجنة المشتركة للتعاون العسكري والتعاون في مجال الفضاء.
وفي العام ٢٠١٦ أدى تعاون البلدين الى إقامة منظمة “اوبك +”. وفي العام ٢٠١٧ زار الملك سلمان بن عبد العزيز روسيا، وكانت تلك أول زيارة تسجلها روسيا لملك سعودي، وتمخضت عن توقيع اتفاقيات قد يكون أهمها السماح بتصنيع أسلحة روسية في السعودية. وخلال أزمة المملكة مع الولايات المتحدة والدول الغربية عام ٢٠١٨، على خلفية مقتل صحافي سعودي في سفارة المملكة في تركيا، حافظت روسيا على علاقات مميزة مع المملكة. وأكد محمد بن سلمان عام ٢٠١٩ على أن التعاون مع روسيا أمر ضروري لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة. وفي العام ٢٠٢١ أبرمت المملكة اتفاقاً عسكرياً مع روسيا، يهدف إلى زيادة التعاون العسكري المشترك بين البلدين. وتفيد بعض التقارير بأن المملكة ستقوم بشراء نظام الدفاع الجوي الروسي “400S”، والتي إن صحت ستكون السعودية البلد الحليف الثاني لواشنطن، بعد تركيا، الذي يتحداها بحصوله على هذا السلاح.
شدد الرئيس الصيني في خطابه في هذه القمة العربية الصينية الأخيرة على مبادئ أساسية راعى بوعي تمايزها عن تلك المبادئ التي حكمت سياسة واشنطن مع حلفائها العرب في المنطقة، وهي تقدير لتاريخ وخصوصية هذه الدول وشعوبها، وكذلك شدد على التأكيد على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، كما شدد على ضرورة المواءمة بين الرؤية الطموحة للسعودية لعام ٢٠٣٠ وبين مبادرة الحزام والطريق، في ظل إعلاء قيمة المصالح المتبادلة، التي ينشدها الجميع.
وتحمل تلك التحالفات الجديدة بين الصين والدول العربية إرهاصات لمستقبل أفضل في منطقة الشرق الأوسط في ظل تقاطع المصالح والتوجهات، فالاقتصاد لا السياسة تبدو أولويات لدول المنطقة، ونبذ الأيديولوجيا أول طريق تحقيق السلام اللازم لتحقيق النمو والتنمية والرخاء الاقتصادي الذي يتطلع اليه الجميع. وتبدو الصين الأكثر تأهيلاً لحل معضلات العلاقة بين الدول الخليجية وعلى رأسها المملكة السعودية مع إيران، في ظل علاقة الصين المميزة والاستراتيجية وأهمية المنطقة العربية الإستراتيجية والإيرانية لتحقيق المشاريع الاقتصادية الطموحة للصين، والتي تحتاج لسيادة حالة من السلم والتفاهم لتحقيقها، وبعد أن كانت واشنطن سبباً لتأجيجها. وتبدو الأمور أشد تعقيداً على واشنطن في ظل اشتراك روسيا مع الصين في رؤيتها لعلاقاتها مع دول المنطقة، والتي تمتلك أيضاً علاقات إيجابية مع دول الخليج وإيران، وتبحث عن تحييد نفوذ واشنطن من المنطقة. وعلى الرغم من عدم نية المملكة العربية السعودية المفاضلة في علاقاتها بين الأقطاب الأميركي والروسي والصين، ولا تبحث عن خسارة أي منها في ظل استراتيجيتها القائمة على البحث عن مصالحها بعيداً عن الأيديولوجيا والاستقطابات، الا أن علاقة المملكة مع واشنطن ليس “زواجاً كاثوليكياً” أي دون طلاق كما وصفه وزير الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل عام ٢٠٠٤، أي بعد الغزو الأميركي للعراق، في ظل أوضاع اليوم التي تختلف لصالح استقلالية سعودية أكبر. ويبدو أن واشنطن لم تنجح في تحقيق الاولوية التي وضعتها بمحاربة النفوذ الصيني والروسي بـ “عدم السماح بخلق فراغ تملأه الصين أو روسيا بين دول المنطقة” على حد تعبير بايدن.
إن عالم اليوم ليس هو ذاته العالم الذي كان في مطلع هذه الألفية، الكثير من الاعتبارات والمفاهيم الدولية قد تغيرت. ولم تعد المقاربة الغربية لتصنيف العالم هي التصنيف الوحيد أو المقبول اليوم، فما بين تصنيف جورج دبليو بوش دول العالم ما بين محوري الخير والشر، وتصنيف جو بايدن لأنظمة العالم ما بين نظم ديمقراطية وشمولية، والذي سمح لأميركا بداية بشن حروب استباقية على أفغانستان والعراق، والآن بتدخلها في السياسات الداخلية للدول وأنظمة حكمها، كما يجري مع الصين وروسيا والمملكة السعودية وإيران ودول أخرى عديدة. كما لم يعد العالم هو ذاته الذي ساد خلال عهد الحرب الباردة والذي تميز بسياسة الاحتواء وفرض التبعية السياسية على أنظمة الحكم وضمان ولاء “الحلفاء”، في ظل منظومة دولية نشأت منذ ثلاثة عقود وتطورت على أساس المنفعة المتبادلة وسيادة لغة المصالح، والذي أنتج اليوم أقطابا مهمة ومتعددة على الساحة الدولية على رأسها الصين وروسيا، ومفهوما يسود اليوم بين دول العالم يقوم على أساس المصلحة لا التحالفات الايديولوجية أو اعتبارات التبعية السياسية. فالولايات المتحدة تنظر إلى حلفائها على أنهم أتباع وليسوا شركاء، وهو ما انتقده الرئيس الفرنسي مؤخراً في علاقة بلاده بالولايات المتحدة، ووصفه خبراء أميركيون بالاستراتيجية النرجسية، والذي تداركته الصين وروسيا في علاقتها مع حلفائها، ليس في الشرق الأوسط فقط وإنما في مناطق أخرى من العالم أيضاً، في ظل سياسة المنفعة والمصالح المتبادلة، وعدم التدخل بالشأن الداخلي للدول، وعدم فرض الأيديولوجيات.
القمة العربية الصينية الأخيرة .. دلالات هامة..
ما رأيك؟
رائع0
لم يعجبني0
اعجبني0
غير راضي0
غير جيد0
لم افهم0
لا اهتم0

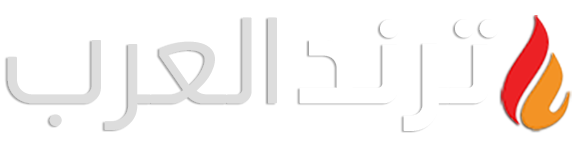






































هل لديك سؤال؟
تابعنا على السوشيال ميديا او اتصل بنا وسوف نرد على تساؤلاتك في اقرب وقت ممكن.