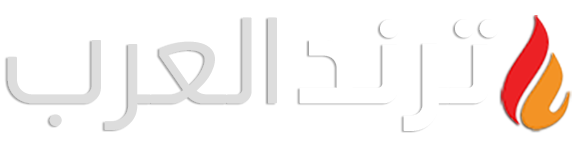مع اقتراب انتهاء حقبة النظام العالمي أحادي القطب، تبدو الإدارة الأميركية في حالة ضعف وحتى تخبط، وذلك بالنظر إلى تولي كل من دونالد ترامب وجو بايدن مسؤولية تلك الإدارة خلال الولايتين الرئاسيتين الأخيرتين، كذلك تبدو السياسة الأميركية في عهد بايدن واضحة تماما كسياسة براغماتية، لا مكان للأخلاق السياسية فيها، وإذا كان ترامب وضع مستقبله في جيب بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية خلال توليه مقاليد البيت الأبيض، ما بين عامي 2016_2020، وذلك بعد أن منحه الهدايا المتتالية، من نقل سفارة بلاده إلى القدس، كذلك الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري، مرورا بصفقة العصر، ثم اتفاقيات أبراهام، فإن بايدن بالمقابل قد وجد نفسه في حالة أسوأ من سابقه، ومستقبله الآن معلق بإصبع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ورغم أن الناخب الأميركي عادة لا يهتم كثيراً بالسياسة الخارجية، أي انه حتى في حال نجح بايدن في جمع السعودية وإسرائيل ضمن اتفاق سلام، أو تطبيع، فإن نجاح بايدن بالبقاء في البيت الأبيض لأربع سنوات أخرى ليس مضمونا، لكن بالنظر إلى فشله في كل ملفاته الخارجية، وآخرها ملف الحرب في أوكرانيا، فإنه حتى فيما يخص الوضع الداخلي، لم يقدم شيئا يستند إليه في دعايته الانتخابية، وبالتالي في إقناع الناخب بإعادة انتخابه رئيسا لولاية ثانية، بل إن أميركا في عهده ما كادت تخرج من التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، التي كانت أحد الأسباب التي ألقت بترامب خارج البيت الأبيض، حتى أثقلت مغامرة بايدن في أوكرانيا كاهل الاقتصاد الأميركي.
ومن مفارقات القدر، أو بمعنى أصح من مفارقات السياسة البراغماتية الأميركية عديمة الأخلاق، أن بايدن تشدق كثيراً بالأخلاق السياسية في حملته الانتخابية السابقة، حين توعد السعودية، وتحديدا الأمير محمد بن سلمان بالملاحقة القضائية فيما يخص قضية مقتل جمال خاشقجي في السفارة السعودية بأنقرة إبان عهد ترامب، لكنه سرعان ما وجد نفسه يذهب إلى جدة خاطبا ود الأمير السعودي، قبل نحو عام، ليقدم هدية لإسرائيل، كانت السماح بمرور الطائرات الإسرائيلية بالأجواء السعودية، ثم سرعان ما وجد بدلا من يائير لابيد في تل أبيب شريكه المناكف نتنياهو، وهكذا لم يكن بمقدوره مع وجود كل من ايتمار بن غفير وبتسئليل سموتريتش، على يمين ويسار نتنياهو في الحكومة الإسرائيلية، إلا أن يغلق أبواب بيته الأبيض في وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية ومعظم وزرائها.
والحقيقة أنه ليس بايدن الذي بحاجة إلى الإنجاز الدراماتيكي متمثلا باتفاق سعودي/إسرائيلي ليكون بمثابة خشبة الخلاص له، بل إن نتنياهو أيضا، يجد نفسه بحاجة ماسة إلى ذلك الانجاز، وذلك حتى يتجاوز مشاكله الداخلية وهي من شقين: شق أمني يتمثل بإدارة الحرب المتواصلة منذ ما قبل تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية مقاليد الحكم، وحتى الآن، نعني حرب الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الفلسطينية، إضافة إلى التحديات الأمنية العديدة في الجبهات الخمس التي يصنفها هكذا رجال الأمن الإسرائيليون أنفسهم، وشق سياسي داخلي، يتمثل بمواجهة المعارضة والتظاهرات الأسبوعية غير المسبوقة التي رافقت تشكيل هذه الحكومة منذ بداية العام وحتى الآن، وذلك على خلفية الصراع المرير حول خطة اليمين الخاصة بتقليص صلاحيات القضاء، كذلك مخاطر تفكك الائتلاف بسبب استحقاق القانون الخاص بالخدمة العسكرية لطلاب المدارس الدينية.
يحلم نتنياهو باتفاق مع السعودية حتى لو شمل تنازلات للجانب الفلسطيني، وحتى لو كان ثمن ذلك خروج بن غفير وتفكيك الائتلاف، لأنه يمكن تعويض ذلك بحكومة مع بيني غانتس، لكن يبقى الثمن الأهم الذي تريده السعودية والخاص بمصالحها، وليس فقط بالملف الفلسطيني، أي الموافقة الأميركية على إنشاء مفاعل نووي سلمي، قد يفضي لإنتاج قنبلة نووية في حال حصلت إيران على السلاح النووي، ليشهد بالتالي الشرق الأوسط سباقا نوويا، وفي هذا الأمر، حجة السعودية قوية، وهي أن أميركا سبق لها وأن وقعت مع إيران اتفاق العام 2015، والسعودية لا تريد أكثر من ذلك، أي الموافقة على إنشاء المفاعل النووي السلمي.
فيما يخص هذا المطلب تبدو المعارضة الإسرائيلية كما سبق وأعلن يائير لابيد أكثر تشددا من نتنياهو، كذلك يبدو بأن المطلب السعودي الآخر، الخاص بعقد اتفاق أمني مع الولايات المتحدة، يعتبرها بمكانة دول حلف الناتو من خارجه، أي اتفاق دفاع مشترك ملزم، يلزم الولايات المتحدة بالدفاع العسكري عن السعودية في حال تعرضت لعدوان خارجي، من نمط تعرض منشأتها النفطية للاعتداء، وهذا أيضا يجد معارضة إسرائيلية، رغم أن الحديث يجري عن ثمن مدفوع من الجيب الأميركي وليس الإسرائيلي.
أما عنصر الوقت فهو ضاغط على كل من بايدن ونتنياهو، في حين أن الأمر ليس كذلك بالنسبة للسعودية، التي ما زالت تدير هذا الملف، أي ملف المفاوضات بينها وبين أميركا، حتى “تطبيع محتمل” بينها وبين إسرائيل بروية وهدوء، وهي دخلت هذا الملف بعد أن أغلقت نافذة العلاقة مع إيران بالتطبيع معها وتبادل السفراء بين الدولتين، وبعد أن أخذت عضوية “بريكس”، ومن قبلها وقعت اتفاقيات خاصة مع الصين بحضور رئيس الصين شخصيا إلى الرياض، ثم بعد أن أرسلت سفيرها إلى رام الله، وبعد أن وقعت بالمقابل اتفاق الممر الاقتصادي مع الهند وأميركا.
والآن تعلن الرياض عن أنها ستقوم بتخفيض إنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يوميا، بدءا من شهر تشرين الثاني القادم، وحتى آخر كانون الأول، من العام الحالي، أي أنها معنية بمصلحتها في الإبقاء على سعر جيد للنفط، وغير معنية بحل مشكلات الغرب، بضخ كميات كبيرة من النفط في مواجهة فصل الشتاء، لتخفيض أسعاره وتعويض مقاطعة الغرب للنفط الروسي.
أما محمد بن سلمان، وإزاء “اندلاق” الإسرائيليين في الحديث المحموم عن اتفاق بات وشيكا مع السعودية، لم يغلق الباب، لأنه يستمتع بإدارة لعبة سياسية مع خصمين سياسيين، يظنان أنهما الأقوى والأذكى، ولم ينتبها بعد إلى أن العالم قد تغير من حولهما في كل جانب واتجاه.
مع ذلك، وعلى هذا الأساس، فإن التكهن بما ستفضي إليه المحاولة الأميركية/الإسرائيلية الجدية وحتى المحمومة للاتفاق مع السعودية، التي لا تبدو بأنها على عجلة من أمرها، مثلهما على الأقل، ليس ممكنا، ذلك أنه بمقدور السعودية، حتى وفق السياسة الواقعية، أن تحقق مطالبها على جانبي الملف، الفلسطيني والسعودي، لكن السؤال هنا الذي ما زال يلقي الضبابية على مآل ذلك السعي من أجل اتفاق محتمل، هو المدى الذي يمكن أن يصل إليه الجانبان الأميركي والإسرائيلي، وإذا كنا نقدر بأنه ليست هناك مشكلة على الجانب الأميركي، فهو أولا يضغط من أجل تقديم شيء ما للجانب الفلسطيني، أي لا يبتعد كثيرا عن المطلب السعودي نفسه، الذي لا يطالب بانسحاب إسرائيلي كامل وفوري من أرض دولة فلسطين المحتلة، لكن تقديم شيء جدي، لا يقتصر على الجانب المالي والاقتصادي، ويقترب مما تطالب به القيادة الفلسطينية من التزام باتفاقيات أوسلو، ومن تحديد جدول زمني للانسحاب، كذلك تحويل جزء من المنطقة ج إلى منطقة أ، كما أن الموقف الأميركي قد لا يجد مشكلة في الموافقة على إنشاء مفاعل نووي سلمي سعودي، لكن تبقى عقبة موافقة الكونغرس، أما المشكلة الحقيقية فهي تكمن في الجانب الإسرائيلي، لأن نتنياهو إذا وجد نفسه من أجل البقاء في الحكم مضطرا للتضحية ببن غفير، فإنه لا يمكنه أن يوافق على اتفاق لا يقبله بيني غانتس.
وهكذا فإن بايدن ونتنياهو اللذين بات مستقبلاهما السياسيان معلقين بإصبع محمد بن سلمان، لن يكون بمقدورهما الحصول منه على خشبة الخلاص بسهولة، فالرجل معني بمصلحة بلاده، وبمستقبله الذي يراه الجميع كتأسيس ثان للمملكة العربية السعودية بعد جده عبد العزيز، يطلقها كدولة حديثة ومركزية في الشرق الأوسط، وكاقتصاد متنوع المصادر وكبير بين دول العالم.

ما رأيك؟
رائع0
لم يعجبني0
اعجبني0
غير راضي0
غير جيد0
لم افهم0
لا اهتم0