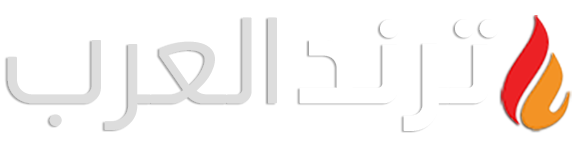بعد مضي فترة قصيرة على تشكيل الحكومة الحالية، تكاد الشائعات لا تتوقف عن تعديلها تارة، وتغييرها تارة أخرى، ويقال إن السبب أن بعض الداعمين الكبار للدكتور محمد اشتية تخلو عنه، وأنها لم تحقق الوعود التي أطلقتها.
ولم تكن الشائعات دائمًا من دون أساس، فلا دخان من غير نار، بل بالفعل تم إبلاغ بعض الوزراء بالاستعداد لمغادرة الحكومة، وتم الاتفاق مع أشخاص ليحلوا محلهم، ثم تدخلت إرادة عليا وألغت كل شيء، وقيل أكثر من مرة إن رئيس الحكومة وضع استقالته بتصرف الرئيس إذا لم تتم موافقته على تعديل واسع للحكومة، أو إن الرئيس أخبره بأن حكومته حكومة تيسير أعمال.
وتتداول في بورصة الأسماء أسماء كثيرة إما رؤساء للحكومة الجديدة، أو ضمن التشكيلة الحكومية، وهي تستهدف جس النبض أو الحرق أو تشتيت الأنظار عن حقيقة ما يعد أو كسب الوقت وإلهاء الرأي العام بأخبار مثيرة، مع أن الرأي العام لا يكترث بهذه الأخبار تمامًا، مثلما لا يكترث كثيرًا بأخبار لقاءات المصالحة؛ لأنه يعرف بالخبرة، أنه سواء عقدت اجتماعات المصالحة أو لم تعقد، وصدرت عنها بيانات واتفاقات أو لم تصدر، وإذا بقيت الحكومة أو عدلت أو غيرت وشكلت حكومة جديدة، فلا شيء جوهريًا سيتغير إذا حصل ذلك؛ لأن تركيبة القيادة والقوى هي نفسها ولم يحدث تغيير مهم عليها، والنهج السائد هو نفسه، وبرنامج الحكومة هو نفسه، وما يقوم به الاحتلال عائق رئيسي في وجه أي حكومة، ولا يعقل أن تكون الحكومة محايدة في ظل الاقتحامات والاغتيالات والاعتقالات، والتوسع المكثف للاستيطان، وهدم المنازل، وتغيير مكانة الأقصى، والعدوان والحصار على القطاع.
يضاف إلى ذلك أن الحكومة لا تحكم، بل إن رئيس الحكومة الفعلي هو الرئيس بعد أن جمع كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يده؛ حيث عاد النظام الرئاسي، وجُعل رئيس الحكومة مجرد وزير أول، وانتهى عمليًا النظام المختلط الرئاسي البرلماني الذي أقيم بعد إرغام الرئيس الراحل ياسر عرفات على قبول استحداث منصب رئيس حكومة، ومنحه صلاحيات واسعة بحجة إجراء إصلاحات على السلطة، في حين أن السبب الحقيقي عدم خضوع أبو عمار لشروط الإدارة الأميركية وإسرائيل وإملاءاتهما.
تعمق التفرد الرئاسي في الحكم
لقد تعمق التفرد الرئاسي بعد تفويض صلاحيات المجلس الوطني للمجلس المركزي، الذي تشكّل في ظل مقاطعة واستبعاد عدد كبير على مقاس الرئيس والقيادة الرسمية، إثر حل المجلس التشريعي، وعدم الذهاب إلى عقد انتخابات جديدة بذريعة عدم سماح الاحتلال بإجرائها في القدس، وفق البروتوكول الخاص بذلك الذي ينزع السيادة عنها، من خلال حصر إجراء الانتخابات في ستة مراكز بريد، وبحد أقصى 6 آلاف منتخب، ومن دون أي تواجد للجنة الانتخابات أو ممثلين عن القوائم أو المراقبين المحليين والأجانب، أو حتى الاستناد إلى توافق وطني يمكن أن يوفر شرعية فصائلية، وفي ظل أن الانقسام مستمر، ويتعمق أفقيًا وعموديًا، ويتم التعايش معه، على الرغم من أن الأغلبية الساحقة من الشعب تدرك الأضرار الكارثية للانقسام، والأهمية الكبرى للوحدة بوصفها قانون الانتصار لأي شعب يمر في مرحلة تحرر وطني من الاستعمار.
شائعات وبورصة أسماء متداولة
قبل اجتماع العلمين، انتشرت الشائعات عن أن رئيس الحكومة وضع استقالته بأيدي الرئيس، وفي رواية أخرى الرئيس أخبره بالاستعداد للرحيل بعد الاجتماع، الذي ستحدد نتائجه أن الحكومة القادمة حكومة وحدة وطنية، أم حكومة وفاق وطني، هذا إذا كانت نتائج الاجتماع إيجابية، وإذا فشل الاجتماع كما حصل فعلًا، ستبقى الحكومة كما هي، أو بإجراء تعديل عليها، أو تشكل حكومة جديدة استعدادًا للتغييرات المحتملة في المنطقة.
وانتشرت شائعات عن تشكيلتين حكوميتين، واحدة برئاسة د. محمد مصطفى، وهو المرشح الدائم لتشكيل الحكومة، والأخرى برئاسة د. علي الجرباوي، فضلًا عن تداول أسماء، مثل: د. عماد أبو كشك، ود. مروان عورتاني، ود. رامي الحمد الله، وحتى محمود العالول تم تداوله بوصفه أحد المرشحين لتشكيل الحكومة.
الملاحظ أن معظم مصادر الشائعات من قمة السلطة والمحسوبين عليها، وفي ظل عدم تدفق المعلومات بشكل رسمي كما يجب، ووفق الأصول تطبيقًا لحق الناس بمعرفة ما يجري؛ يكون للشائعات تأثير مضاعف، فضلًا عن إقبال الجمهور إلى استقاء المعلومات من وسائل الإعلام الإسرائيلية ووسائل التواصل الاجتماعي.
هل يتم تعديل الحكومة أم تغييرها أم بقاؤها؟
لا أحد يدري سوى شخص واحد، وهو الرئيس محمود عباس، الذي يملك الصلاحية، ولا توجد أي مؤسسة لا في السلطة أو المنظمة لها سلطة عليه أو تشاركه فعلًا في اتخاذ القرار، وبالتالي إذا بقيت الحكومة أو عدلت أو غيرت لا فرق ولا يهم ما دام رئيسها الفعلي هو الرئيس، وما دامت سياسته هي هي والدلائل كثيرة، منها أن وزارات الخارجية والداخلية والمالية ووزارات أخرى يعين وزراءها الرئيس، ونواب رئيس الحكومة من رجال الرئيس، والإعلام والأمن تحت سلطته، وكلنا نذكر مرات عدة كيف صرح وزير المالية تصريحات تخالف تصريحات رئيس الحكومة، وثبتت صحة ما صرح به الوزير ممثل الرئيس، فضلًا عن إصدار قوانين لا يعلم عنها رئيس الحكومة شيئًا.
وعلى ما يبدو أن الرئيس يتعامل مع الأمر على النحو الآتي: إذا بقيت حكومة اشتية فهي مشكلة، كونها أخفقت وباتت محل انتقاد كبير، وتتجاذبها الصراعات والتنافس داخل حركة فتح والسلطة، لذا من الجيد أن تكون كبش محرقة، وإذا استبدلت فهي مشكلة كذلك؛ لأن التغيير يعطي الناس أملًا في حصول جديد، في حين لا يوجد جديد، فالصفقة السعودية الإسرائيلية غير مضمونة على الرغم من الاهتمام الأميركي المكثف بإنجازها، فالأعمال ستجري كالعادة ما دام النهج والسياسات والخطط وحتى الأشخاص لم يتغيروا، فلا أفق سياسيًا، بل يتم إحكام إقفال إغلاقه، مع تبوء الحكومة الإسرائيلية الحالية التي برنامجها وهمها الأساسي ضم الضفة، وتكريس أنها جزء من إسرائيل، وأن سكانها إما أن يقبلوا بذلك، أو يرحلوا، أو مصيرهم القتل أو السجن، فضلًا عن عدم وجود إستراتيجيات فاعلة ومناسبة، فالموجود سياسة ردود أفعال، والتعامل مع كل يوم بيومه، بينما يتم الحديث عن الشعارات الكبرى، مثل العناقيد، والانفكاك عن الاحتلال، بوصفها مجرد استهلاك إعلامي، فالوضع يزداد سوءًا والتبعية الاقتصادية للاحتلال تزيد.
على الرغم من كل ذلك، يمكن أن نشهد تعديلًا حكوميًا بتغيير عدد من الوزراء، أو حتى تشكيل حكومة جديدة، فهناك مطالبات داخلية من الطامحين بوراثة الحكومة وخارجية من الإدارة الأميركية تحديدًا، التي ترى من الأهمية بمكان إجراء تغيير حكومي يرأسه شخص يتبنى برنامجًا إصلاحيًا، ويعدّ هذا التغيير الحكومي جزءًا من خطة متكاملة هدفها وقف ضعف السلطة وتآكلها ومنعها من الانهيار، والأجزاء الأخرى تتعلق بتقديم تسهيلات إسرائيلية، مثل التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأخير، ووقف اعتداءات المستوطنين، ووقف برنامج الضم السريع، بينما الضم المتدرج للأرض الفلسطينية مستمر، وهذا أمر يمكن التعايش معه.
وجهة النظر الأميركية: رئيس وزراء إصلاحي
إذا أردنا التعرف إلى وجهة النظر الأميركية، علينا أن نقرأ المقال الذي كتبه كل من غيث العمري، ودينيس روس المقرب جدًا من إدارة بايدن. فقد جاءت خلاصة المقال الذي عنوانه “لماذا يشكل ضعف الرئيس عباس خطرًا على إسرائيل” في العبارة التالية التي كانت في صدارته: “من أجل استتباب الأمن وتوسيع “اتفاقية إبراهيم”، على واشنطن وحلفائها اتخاذ خطوات عاجلة لمنع السلطة من الانهيار، كالعمل على قيام الدول المانحة بالضغط لتعيين رئيس وزراء إصلاحي، وزيادة فرص العمل للفلسطينيين الشباب الذين لم يعودوا يرون سببًا للامتناع عن العنف”.
إذًا، لا يرى كاتبا المقال أن جذر الصراع هو الاحتلال، وما يقوم به من جرائم وقتل بدم بارد وكل أشكال العدوان، بل يساوي بين عنف وإرهاب الفلسطينيين وعنف المستوطنين، لذا الهدف الأساسي مساعدة إسرائيل، عبر توسيع اتفاقات التطبيع العربية مع إسرائيل بدلًا من معاقبتها على جرائمها وقتل عملية السلام، وهذا ينسجم مع وضع إدارة بايدن هدفها المركزي التطبيع بين السعودية وإسرائيل، على أن يتحقق مع نهاية العام الحالي وحتى آذار القادم، مع بدء الحملة الانتخابية الرئاسية، ومن نتائج هذا الجهد (التطبيع إذا نجح وليس من السهل أن ينجح) تقديم دعم سخي للسلطة مقابل موافقتها على الصفقة الكبرى (إذ أشارت المعلومات إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أبلغ الرئيس محمود عباس أن فلسطين جزء من الصفقة) التي يعني إبرامها هيمنة إسرائيلية على المنطقة، من خلال فتح أبواب الدول العربية والإسلامية أمام حكام تل أبيب، وإبعاد السعودية عن الصين وروسيا وإيران، وإخراج إسرائيل من أزمتها الراهنة، وشق الطريق لصفقة قرن جديدة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل أهدأ ومتدرج، وليس مرة واحدة كما سعت صفقة ترامب.
ويعدّ المقال المشار إليه أعلاه أن السلطة تفتقر إلى الشرعية الشعبية لأسباب متعددة، منها: الفساد المستشري، وسوء الحكم، وعدم استعدادها لإجراء انتخابات، وأن نظامها السياسي المتصلب يمنع ارتقاء قادة محتملين أصغر سنًا، إضافة إلى غياب أي رؤية سياسية حقيقية أو إنجازات تجاه الإسرائيليين.
ويتجاهل أن مسؤولية غياب الرؤية السياسية تتحمل السلطة المسؤولية عنه، وهو ناجم عن قتل عملية التسوية من قبل حكومات إسرائيل، وتغاضي الإدارات الأميركية عن ذلك، وتوفير الحماية لها، ومنع مساءلتها ومعاقبتها، وأكثر من ذلك الضغط على القيادة الرسمية لانتظار إحيائها في وقت لا يعلم أحد متى سوى الله، وبذل كل المستطاع لمنع السلطة من تبني مسار آخر قادر على تحقيق الأهداف والمصالح الفلسطينية.
أما عدم إجراء الانتخابات فهو تم بتشجيع ودعم أميركي إسرائيلي خشية من فوز حركة حماس، أو من حصولها على الشرعية، حتى لو لم تحصل على الأغلبية.
وأما سوء الحكم، خصوصًا الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، فهي في جزء أساسي منها تعود إلى الوظيفة السياسية والاقتصادية والأمنية للسلطة، التي أقامت هوة واسعة بين القيادة وشعبها. هذه الوظيفة التي تريد إدارة بايدن المحافظة عليها، من خلال التمسك بالاتفاقيات التي تجاوزتها الحكومات الإسرائيلية منذ زمن بعيد، وذلك لتوفير الأمن للاحتلال، واعتبار المقاومة المشروعة له “إرهابًا”.
هل يتصور روس والعمري إمكانية قيام سلطة ديمقراطية رشيدة تحت الاحتلال والانقسام، وتكافح الفساد مع بقاء المسار الذي تسير فيه، من دون شرعية وطنية وانتخابية، خصوصًا بعد موت العملية السياسية، ووضع سقف أمني اقتصادي للعلاقات الفلسطينية الإسرائيلية بعيدًا عن الحقوق الفلسطينية، حتى المقرة في الشرعية الدولية، وحتى بعيدًا عن الاتفاقيات الظالمة التي عقدتها منظمة التحرير مع الحكومة الإسرائيلية، أم أن الأمر كله يتمحور حول كيفية مساعدة إسرائيل، ولو عن طريق إنقاذها من نفسها، وهذا ما لا يقوله المقال بصراحة بأن تشكيل حكومة فلسطينية قوية “إصلاحية” يمكن أن يضمن أمن الاحتلال، وانتقال السلطة بشكل سلس في حال حدوث شغور في منصب الرئيس.
المطلوب تغيير المسار
الفلسطينيون بحاجة إلى تغيير المسار الذي ساروا فيه منذ ثلاثين عامًا تغييرًا جذريًا في إطار رؤية شاملة جديدة، وفي سياق عملية التغيير الشاملة يكون تشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة أمرًا يحدث فرقًا، وعندها ستأتي هذه الحكومة في إطار تغيير دور السلطة ووظائفها والتزاماتها وموازنتها، لتكون سلطة مجاورة للمقاومة، وأداة في خدمة المنظمة الموحدة والبرنامج الوطني المشترك، وهذا غير وارد حتى إشعار آخر.