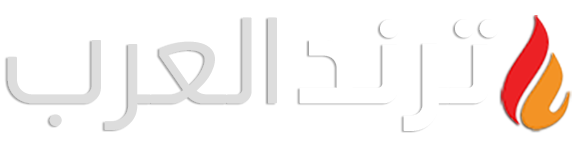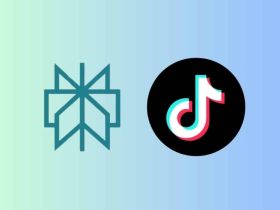ستأخذ “ليلة حرق حوارة” موضعها في الوعي الفلسطيني، ليست كحدث شديد الفظاعة شكل ذروة في إرهاب المستوطنين المحميين من جيش الاحتلال ضد أبناء شعبنا فقط، بل ستدخل هذا الوعي كنموذج لفعل استيطاني صهيوني فاشي مفتوح على احتمالات تنفيذه في أي لحظة ضد قرى وتجمعات فلسطينية في كل مكان على جانبي الخط الأخضر، وما تصريحات سموتريتش الداعية إلى محو حوارة، إلا تأكيدا للفعل الحاضر والمستقبلي بهذا الخصوص.
“لتحترق لهم القرية”، هي أصلا “عقيدة” تحولت إلى نشيد جماعي يردده المستوطنون ومن يعتنقون أيديولوجيتهم الصهيونية الدينية المتطرفة، ليس في المناسبات والاحتفالات الدينية والاستيطانية ذات العلاقة فقط، بل وفي حفلات الزفاف والطهور وعلى مدرجات كرة القدم، عندما تكون المنافسة مع فريق عربي بشكل خاص، وقد يضيفون له اسم القرية العربية الفلسطينية المتناسب مع الحدث على غرار “شعفاط تحترق” الذي تردد على ألسنة الآلاف في استاد “تيدي” في القدس مؤخرا.
كذلك، غني عن البيان أن حرق المساجد والكنائس والمنازل الفلسطينية، هي جزء أصيل من العمل الإرهابي الذي مارسته عصابات المستوطنين ضد أهلنا ومقدساتنا على جانبي الخط الأخضر، ابتداء من محاولة إحراق المسجد الأقصى مرورا بحرق كنيسة “الخبز والسمك” في طبرية، وانتهاء بحرق جثة الطفل محمد أبو خضير بعد قتله، وإحراق عائلة دوابشة الفلسطينية داخل بيتها في قرية دوما، شمالي الضفة.
بالرغم من ذلك، فإن عملية “حرق حوارة” هي الأولى التي تستهدف قرية كاملة وبشكل علني ومنظم وبتواطؤ وحماية تصل حد الشراكة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي سابقة يجدر التوقف عندها مليا، ومن المفيد في هذا السياق أن نرجع إلى كتاب “يطلقون النار ولا يبكون – العسكرة الإسرائيلية الجديدة في سنوات الألفين”، لمؤلفه يغيل ليفي، وهو كولونيل احتياط وبروفيسور في العلوم الاجتماعية، لفهم التحولات التي طرأت على الجيش الإسرائيلي ومسألة التداخل بينه وبين المستوطنين.
وفي مقابلة أجرته معه صحيفة “هآرتس”، يتحدث ليفي عن انفصام في الجيش الإسرائيلي وظهور ما يسميه “جيش شرطوي” يعمل في الضفة الغربية المحتلة، وهو يتشكل من جنود الياقات الزرقاء الذين يقفون على الحواجز ويقتحمون بيوت الخليل في منتصف الليل ويكرسون استمرار السيطرة على الفلسطينيين.
ويقول إن قضية الجندي أزاريا (قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف في آذار/ مارس عام 2016 من مسافة قريبة، بينما كان الشهيد مصابا على الأرض)، أكدت وجود مسارات اجتماعية تؤدي “الجيش الشرطوي” الذي يتألف أساسا من جنود ذوي خلفية معينة؛ متدينون، شرقيون تقليديون، سكان الضواحي، مستوطنون، وقادمون جدد، هؤلاء لن يكون الجيش بالنسبة لهم رافعة اقتصادية مثل نظرائهم، بل ربما يخرجوا من الجيش كعاملي حراسة ومحطات بنزين ويتحولون إلى “كيس الرمل” الذي يتلقى الضربات عن المجتمع، وبالرغم من أنهم كيان مستقل (جيش شرطوي) إلا أنه يعاني من الإحباط ويتجه نحو التطرف، ولتنفيذ مهامه يحتاج هذا الجيش إلى غض طرف الجيش الرسمي وإلى تعاون المستوطنين.
هذا الجيش لا يشعر بأي التزام تجاه حماية الفلسطينيين، بل هو يشعر أن وظيفته، هي تشكيل ذراع رمادية للدولة في ضم مناطق بواسطة استعمال أساليب عمل لا يستطيع الجيش الرسمي اتباعها، تنطلق من التسليم بعنف المستوطنين، كما أفاد بحث أجرته رئيسة قسم السلوك في الجيش الإسرائيلي، د. هداس براند، قبل عقد من الزمن.
وفي إشارة إلى تبدد الحدود بين ما يسميه “الجيش الشرطوي” وبين المستوطنين، يورد الكاتب خطابا لقائد وحدة “السامرة” في الجيش الإسرائيلي، روعي تسويغ، وهو يخاطب مجنديه الذين أرسلهم إلى قبر يوسف، قائلا: “في هذا المكان وعد أبانا إبراهيم بهذه الأرض. ونحن اليوم نسير بثقة كاملة على درب الإباء”.
القائد المذكور هو إسرائيلي علماني وليس خريج كلية تابعة للتيار الديني المتزمت، كما يقول، ما يعكس كيف تغلغلت القيم الدينية للجنود العلمانيين في الجيش الشرطوي، وهو جزء من تبدد الحدود الجوهري بين المستوطنين و”الجيش الشرطوي” المنتشر في الضفة الغربية، حتى بات من الصعب على القادة العسكريين التمييز بين مبادئ العمل المناسبة للجيش وبين تلك المناسبة للعصابات المحلية المسلحة، وفي ظروف تشير فيها كل الدلائل إلى أن قادة الجيش يخدمون مشروع الاستيطان، من الطبيعي أن يتلاءم خطابهم أيضا مع هذا الواقع، كما يقول ليفي.