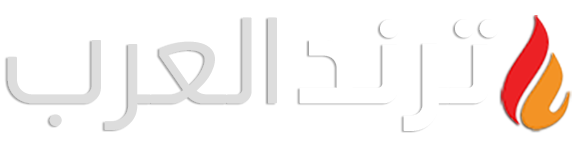معاريف – بقلم: د. ميخائيل ميلشتاين التصعيد المتزايد في الأسابيع الأخيرة بالساحة الفلسطينية وفي مركزه العمليات القاسية بالقدس والضفة، ليست غير مسبوقة في خطورتها ومزاياها. ومع ذلك، فإنها تنطوي على جوانب تعكس سياقات عميقة – سواء في إسرائيل أم في أوساط الفلسطينيين – توفر قوة للاطلاع على سيناريوهات رعب قد تتحقق في المستقبل غير البعيد. ينشأ التصعيد اليوم عقب لقاء بين عنصر يعيش ضعفاً متزايداً (السلطة) ولاعب أقوى (إسرائيل)، غارق في عاصفة داخلية شديدة ويصعب عليه اتخاذ سياسة مرتبة، بينما تعتمل في الوسط ساحة شديدة القوة تملي الوتيرة ومسار الأحداث، وتتجه نحو مواجهة جبهوية شديدة.
تشكل العمليات الأخيرة تواصلا ًلموجة التصعيد التي سادت منذ نحو سنة (منذ رمضان الماضي). قسم كبير منها يقوده شبان يعملون بشكل مستقل أو في إطار خلايا صغيرة ومنظمات محلية، مثل “عرين الأسود” في نابلس الذين يحرصون على الامتناع عن التماثل مع أحد الفصائل فما بالك مع السلطة. يدور الحديث عن تعبير عن ميول عميقة اجتماعياً وعلى رأسها صعود جيل الـ Z الفلسطيني الذي ولد بعد العام 2000. هذا الجيل يشعر بانقطاع عميق عن معظم مصادر المرجعية حوله وباغتراب تجاه القيادة وشعارات الماضي، وهو متأثر عميقاً بمجال الشبكة الذي يشكل له في الوقت نفسه وسيلة تعبير وأداة تغذية فكرية.
بدون راشدين مسؤولين
خطورة التهديد الذي ينطوي عليه منفذو العمليات الأفراد أو الخلايا المحلية، أقل ظاهراً مقارنة بالشبكات العسكرية المؤطرة كشبكات حماس والجهاد الإسلامي، لكن هذا النموذج يطرح تحدياً قاسياً أمام إسرائيل. فمن الصعب على محافل الاستخبارات أن تشخص مؤشرات أولية لقسم من الأعمال أو تضرب بنى تحتية ذات مبنى تنظيمي غامض لا يعتمد دوماً على مراتبية ثابتة. يؤكد الأمر عدم الجدوى في الدعوات للعمل على “سور واق 2” وبالتأكيد في شرقي القدس – خطوة مختلفة جوهرياً عن المعركة قبل عقدين (الانتفاضة الثانية وحملة السور الواقي 2) التي وقف فيها عدو محدد وواضح أمام إسرائيل.
يوفر الضعف المتزايد للسلطة خلفية تسمح أو تغذي موجة التصعيد. فالحكم الفلسطيني يحظى بصورة سلبية في الشارع الفلسطيني، وخصوصاً بسبب مظاهر الفساد والمحسوبية وانعدام الديمقراطية، إلى جانب اتهامه بالتعاون مع إسرائيل، وباعتباره جسماً تقوده قيادة كبيرة في السن ومنقطعة تبدي عدم ثقة وعدم دافعية لفرض إمرتها على الشارع. نشأت على هذه الخلفية فراغات سلطوية في جنين وبقدر كبير أيضاً في نابلس وأريحا، تستوجب من إسرائيل نشاطاً عسكرياً متزايداً. يخلق الأمر احتكاكات عنيفة قاسية ويشكل مرجلاً لتعزيز قوة حماس في المنطقة ونشوء فوضى تقودها شبكات محلية تتشكل أحياناً من زعران وذوي سوابق يكتسون صورة مقاتلين من أجل أهداف وطنية. إن الاتساع المستقبلي لتلك الفراغات قد يطالب إسرائيل بأن تعنى بالسكان وأداء صلاحيات مدنية في ضوء العجز المتزايد من جانب السلطة التي قد تذوي أو تضعف من ناحية الأداء.
في مثل هذا الوضع، يمكن لإسرائيل أن تساعد بقدر ما على تعزيز وظيفي للسلطة، من خلال دعم اقتصادي أو استجابة لطلبات نجاعة أجهزة الأمن الفلسطينية مثلاً، لكن لا يمكنها أن تؤدي إلى تغيير دراماتيكي في مكانة الحكم الفلسطيني بعصا سحرية. تعزيزه اليوم لا ينشأ عن بدء مفاوضات سياسية أو سلام اقتصادي (أقوال كانت صحيحة في الماضي)، بل إشفاء داخلي عميق، وبدونه ستكون مكانة الحكم الفلسطيني من الداخل موضع شك، حتى بلا صلة بالواقع السياسي أو الاقتصادي الذي سيسود في الساحة الفلسطينية.
إن الفوضى في المجال العام والسياسي في إسرائيل بعامة وداخل الحكومة بخاصة، تعظم الاحتمال لاحتدام التصعيد الحالي. في الحكومة اليوم أجندتان متنافستان وعملياً متناقضتان في الموضوع الفلسطيني: تلك “الثورية” التي يقودها بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير وتسعى لإحلال السيادة في “المناطق” [الضفة الغربية]، وإزالة السلطة وتسريع الاستيطان في ظل إعطاء اهتمام محدود للآثار الدولية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الخطوات؛ ومقابلها نهج سائد لكن متردد يتخذه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ينطوي على تطلع لاستقرار وحفظ ما هو قائم، بما في ذلك تعزيز السلطة في ظل تنسيق وثيق مع لاعبين خارجيين.
لقد نشأت صدوع بين النهجين عقب إخلاء بؤرة “أور حاييم” والكرم الموجود في منطقة “بنيامين”، وقضية الخان الأحمر، والخصام في مسألة تبعية وحدة تنسيق أعمال الحكومة في “المناطق”. وأصبح التوتر المتراكم صخرة خلاف كأداء عقب مؤتمر القمة في العقبة، الذي تبلورت في إطاره تفاهمات بين إسرائيل والفلسطينيين، هاجمها سموتريتش وبن غفير بشدة، وكذا أعمال الشغب في حوارة التي عكست فجوة بين التنديد السريع والذي لا لبس فيه من جانب رؤساء الليكود وبين إعلان سموتريتش عن الحاجة إلى “محو حوارة” الذي يعكس فكره وجوب إيقاع الهزيمة بالفلسطينيين في ضوء “عقيدة يهوشع بن نون”: إما أن يقبلوا إمرة إسرائيل أو يتركوا “المناطق” أو يقاتلوا اليهود؛ دون أي بديل رابع من الحوار أو الحل الوسط بين الشعبين.
هدوء حتى رمضان وفي أثنائه
حتى في حالة حكومة “اليمين بالكامل”، من شأن الموضوع الفلسطيني أن يكون أساس تقويض بوسعه حتى أن يؤدي إلى نهاية الائتلاف. كما أن الأمر يجسد أن كل الحكومات مهما كانت، لا يمكنها أن تفر من الموضوع الفلسطيني ولا أن تخفيه من خلال “ضمادات” سلام اقتصادي أو هدنات أمنية. فهذه تتمزق في غضون وقت قصير نسبياً لتؤكد أنه بدون نقاش عميق وبدون قرارات حاسمة، فإن المشاكل الأساسية تحتدم، ونهايتها أن تتفجر بالمفاجأة في وجه إسرائيل، في ظل الإلزام بتوفير جواب من موقف دوّن استراتيجياً.
في المرحلة الحالية، على الحكومة أن تركز على أهداف متواضعة نسبياً من حيث تحقيق الهدوء حتى رمضان وفي أثناء الشهر إياه. يمكن للأمر أن يتحقق من خلال الالتزام بالتفاهمات التي تحققت في مؤتمر العقبة، وتشجيع السلطة بمشاركة الأمريكيين على الدخول إلى الفراغات التي نشأت في “المناطق” (دون تطوير توقعات زائدة)، وتقييد العقاب الاقتصادي المفروض على السلطة في الأشهر الأخيرة، والامتناع عن الحديث عن إزالتها. هذه مسألة مطلوب فيها أن نستوعب رغم نواقص السلطة الفلسطينية، أنها لا تزال أهون الشرور مقابل بدائل الفوضى، والسيطرة الإسرائيلية أو سيطرة حماس على قسم من الضفة أو عليها كلها. يجب مواصلة سياسة حذرة وعاقلة في موضوع الحرم، التي “أثبتت” أنه لا يزال ممكناً أن يتصور تصعيد حاد بين إسرائيل والفلسطينيين. وكل هذا، في ظل إيضاحات لا لبس فيها وجلية من نتنياهو حول الأجندة المتصدرة للحكومة، مع التشديد على الرفض القاطع لظواهر محملة بالمصائب كأعمال الشغب في حوارة.
بين هذا وذاك، وفرت أحداث الأسبوع الماضي فهماً معمقاً لمعنى دولة واحدة بين البحر والنهر. فقتل الشابين الإسرائيليين قرب حوارة، ثم هجمة المستوطنين الإسرائيليين منفلتة العقال على سكان القرية، هي واقع بلقاني قد يصبح نمط حياة يومية، خصوصاً عندما تعيش مجموعتان سكانيتان ذواتا روايتين قطبيتين ومعاديتين عميقاً في كيان واحد دون فاصل مادي. عندما تجتاز إسرائيل الأشهر القريبة بسلام ثم يتبلور إجماع داخلي يبدد التوتر الداخلي الشديد، من الضروري أن يبدأ نقاش استراتيجي طويل المدى في الموضوع الفلسطيني قبل لحظة من الوصول إلى نقطة اللاعودة التي ينشأ فيها دون تخطيط ووعي أو إرادة واقع الدولة الواحدة.