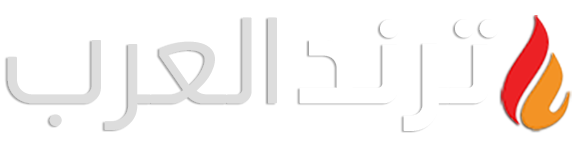أجرى منير النصراوي، والد لامين يامال، لاعب برشلونة، أول مقابلة له منذ تعرضه لمحاولة اغتيال وطعنه بسكين.
وتم نقل منير النصراوي إلى المستشفى بعد تعرضه لهجوم يوم الأربعاء، وتلقى عدة طعنات بسكين من ثلاثة أشخاص.
واعتقلت الشرطة الإسبانية منذ ذلك الحين ثلاثة أشخاص بتهمة محاولة القتل، وأكدت أن رابعًا تم اعتقاله منذ ذلك الحين (طالع تفاصيل المشادة من هنا).
تحدث نصراوي إلى البرنامج الإسباني “El Chiringuito”، ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تصريحاته.
وقال: “الحمد لله أنهم أخذوني للتو إلى الجناح وأنا أفضل قليلاً، يجب أن نكون أكثر هدوءًا، من أجل مصلحة الجميع، من أجلي ومصلحة عائلتي”.
وأضاف: “يجب أن أكون أكثر هدوءًا لأنه ليس لدي خيار آخر، يجب أن نفكر في أن العدالة ستؤدي مهمتها وستفعل ذلك بالتأكيد، هذا هو الشيء الأكثر أهمية، الحمد لله الذي هو عظيم جدًا، كل شيء له حل”.
وأكد: “بالطبع كنت خائفًا، رأيت نفسي بين الحياة والموت، خائفًا مثل أي إنسان”.
وأوضحت تقارير الصحف الإسبانية أن النصراوي كان يسير في حي روكافوندا وتم إلقاء المياه عليه من الشرفة، مما أثار غضب والد لامين يامال وبدأت مشاجرة صغيرة وأسفرت عن تدخل الشرطة.
وقام ثلاثة أشخاص بطعن والد لامين يامال بسكين وقد تم إصابته بثلاث طعنات في موقف للسيارات في حي روكافوندا بمدينة ماتارو، وألقت الشرطة لاحقًا القبض على المتهمين بعد شهادة الشهود الذين تواجدوا في مقر الحادثة.
وشوهد لامين يامال في المستشفى أمس الخميس حيث قام بزيارة والده للاطمئنان على حالته، كما كان رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا من بين الذين زاروا والد اللاعب في المستشفى بعد الطعن.