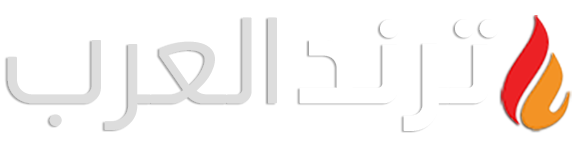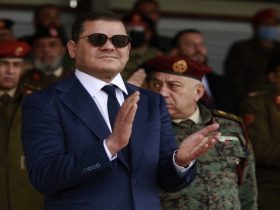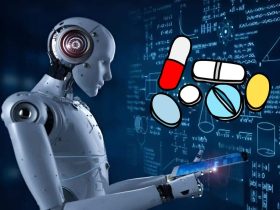إسرائيل اليوم – بقلم أرئيل كهانا- “أطلب أن يسجل في البروتوكول اعتراضي على الدفعات للسلطة الفلسطينية”، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. كان هذا في إحدى الجلسات الأولى لكابينت الحكومة الحالية. بحث الوزراء في تحويلات المال للسلطة الفلسطينية وفي التزاماتها الكثيرة تجاهنا. كمن يمسك بصنبور مالية الدولة ويرى في الكيان الفلسطيني جسماً داعماً للعمليات، أراد وزير المالية إغلاق الصنبور.
لكن نتنياهو لم يستطب ما قيل. “إذن، ما بديله؟” رد متسائلاً. طور الرجلان على مدى الزمن شبكة علاقات جدية ومحترمة. علم نتنياهو بأن ملاحظة سموتريتش لم تكن لملاحقته سياسياً، بل تعكس فكره. هو أيضاً، نتنياهو بعيد جداً عن أن يكون عاشقاً للثمرة المركزية الفجة التي خلقتها اتفاقات أوسلو – السلطة الفلسطينية. غير أنه لا توجد إمكانية عملية أخرى على حد نهجه.
رد سموتريتش على سؤال رئيس الوزراء، بجواب يفهم منه أنه لا بديل فورياً للسلطة الفلسطينية. “إذا كان كذلك، أطلب شطب الأقوال من البروتوكول”، أجاب نتنياهو. وسموتريتش وافق.
إن تبادل الحديث هذا، في الكابينت الأكثر يمينية على الإطلاق، يعكس وضعنا على أتم وجه بعد 30 سنة من التوقيع على اتفاقات أوسلو. أما إسرائيل فلا تريدها ولا تستغني عنها؛ لا تبتلعها ولا تلفظها.
إسرائيل لا تستغني عن السلطة الفلسطينية، لأنها أولاً وقبل كل شيء تدير الحياة المدنية لملايين العرب الذين يعيشون في “يهودا والسامرة” (عددهم الدقيق غير معروف، وهذا يؤدي دوراً في المواجهة الوجودية التي بينهم وبيننا). لها شرطة وموظفون فلسطينيون مسؤولون عن القمامة والمجاري والتأمين والتعليم لأبناء شعبهم، وهذا يوفر على إسرائيل العبء اليومي الجسيم والغالي. وهو أيضاً ما يسمح لإسرائيل بالادعاء أمام العالم أنها ليست دولة أبرتهايد ولا احتلال أيضاً؛ إذ إن معظم عناصر حياة الفلسطينيين يديرونها بقواهم.
في الزاوية الأمنية، تشارك السلطة الفلسطينية بدور لا بأس به وإن لم يكن كبيراً جداً، في إحباط العمليات ضد اليهود. فلولم تكن أو لا تكون قائمة، فإن جنود الجيش الإسرائيلي، النظامي والاحتياط، سيكونون على ما يبدو مطالبين بالعمل في مناطق “يهودا والسامرة” بحجوم أكبر بكثير مما هم اليوم.
لهذه الأسباب الثقيلة الوزن، السياسية والأمنية والاقتصادية، فإن أي حكومة إسرائيلية، حتى في الأوضاع الأصعب التي لم تنقص، لم تتراجع قط عن اتفاقات أوسلو ولم تلغ الاعتراف بالسلطة الفلسطينية. فضلاً عن هذا، تكرس إسرائيل جهوداً عليا لمواصلة وجود السلطة. فمن أجلها تعرض مصالح أمنية للخطر، وتتحمل أضراراً سياسية وتدفع كثيراً جداً من أموال دافع الضرائب الإسرائيلي.
رواتب منفذي العمليات قبل كل شيء
نبدأ من الأمن. للاستمرار في بقاء السلطة على قيد الحياة، يقتل يهود. ولأجهزة الدعاية التي تستخدمها رام الله منذ 30 سنة دور حاسم في تشجيع العمليات، سياسيوها، الإعلام، الجامعات والمدارس الفلسطينية يروجون لكراهية إسرائيل – كراهية تترجم إلى عمليات في كل البلاد. إضافة إلى ذلك، أفراد غير قليلين من الشرطة الفلسطينيين يشاركون في العمليات.
إن مساهمة السلطة الفلسطينية في العمليات تجد تعبيرها ليس فقط في الكلام، بل وبالشواكل أيضاً والكثير منها. هذه هي رواتب العمليات، التي ساءت سمعتها في كل العالم. لا يوجد كيان سياسي في العالم يدفع مالاً لرعاياه كي يقتلوا اليهود، باستثناء السلطة الفلسطينية.
تدفع لمنفذي العمليات ولأبناء عائلاتهم المال بواسطة م.ت.ف، وهذا يزداد كلما زاد المصابون. هذه المخصصات تلعب دوراً حاسماً لدى كثيرين ممن يخرجون لقتل اليهود. فهم يعرفون أنهم إذا ما نجوا من العملية، فإنهم سيثابون على طوال حياتهم. إذا ماتوا، سيكون الأمن الاقتصادي مضموناً لعائلتهم. هذه الحجة ليست نظرية، بل مثبتة عملياً. منفذي العمليات الذين بقوا على قيد الحياة وخضعوا للتحقيق اعترفوا غير مرة بأن المال كان دافعاً.
إضافة إلى ذلك، بإلهام تعبير “ضع المال حيث كلماتك” فإن إصرار أبو مازن على دفع مخصصات منفذي العمليات، التي تشكل نحو 10 في المئة من ميزانية السلطة، يبث لشعبه رسالة لا لبس فيها. حتى عندما تنتهي السيولة النقدية، ولا مال لدفع رواتب الموظفين وتقف السلطة على شفا عدم قدرة التسديد، فإنه غير مستعد لخصم شيكل من رواتب منفذي العمليات الرسالة، أن قتل اليهود أهم.
“شهادة أهلية لعظيم الإرهابيين”
تمس السلطة الفلسطينية بشكل حقيقي بإسرائيل في المستوى الدولي. دعاواها ضد الإسرائيليين معلقة في المحكمة الدولية في لاهاي. وهي تبادر صبح مساء بإجراءات مناهضة لإسرائيل في مجلس الأمن ومؤسسات الأمم المتحدة. مع أن قوتها صغيرة أكثر مما في الماضي، لكنها تشهر بإسرائيل في العالم العربي، وتشكك بشرعية أعمالها للدفاع عن نفسها. ويتغذى الإعلام الغربي منها، فيما تدفع إسرائيل الثمن بسمعتها الطيبة.
إن الضرر الأشد الذي أوقعته اتفاقيات أوسلو، فضلاً عن آلاف القتلى، هو التشكيك في حق دولة إسرائيل في الوجود. في التوقيع على إعلان مبادئ في 13 أيلول 1993 اعترفت إسرائيل عملياً بشرعية الادعاء العربي على البلاد. هذا الاعتراف السخيف الذي لا أساس تاريخياً له أيضاً، سحق أحقية ادعاء الحركة الصهيونية لبلاد إسرائيل أو على الأقل ساوى بين ادعائهم وادعائنا. هذه ضربة أخلاقية لم ننتعش منها بعد.
إضافة إلى ذلك، شرعنت الاتفاقات أحد أكبر “الإرهابيين” الذين عرفهم العالم بعد الحرب العالمية الثانية، ياسر عرفات؛ مما أسقط أيضاً مواقف أخلاقية وتاريخية أطلقتها إسرائيل أمام العالم لعشرات السنين. يمكن القول إننا في أوسلو بدأنا نخسر تأييد الجانب الديمقراطي في الخريطة الأمريكية؛ فبعد الاتفاقيات كان الاتهام بغياب السلام يلقى على “الطرفين”. حتى ذلك الحين، كان الديمقراطيون إلى جانبنا.
ألحق الضرر السياسي بدوره أثماناً أمنية؛ فالفلسطينيون يطالبون بألا تدخل إسرائيل إلى نطاقات يفترض أن تكون بسيطرتهم الكاملة، أي المدن المسماة المنطقة “أ”. في الست سنوات التي بين 1995 و2001 استجابت إسرائيل لهذا المطلب رغم معرفة أن مختبرات” إرهاب” بحجوم هائلة نبتت فيها. كلفنا غض النظر هذا آلاف ضحايا الانتفاضة الثانية.
منذئذ تعلمنا الدرس، والجيش الإسرائيلي يدخل بالفعل إلى المدن العربية كي يعتقل منفذي عمليات. لكن الفلسطينيين يواصلون الثوران ضد هذه الأعمال. وبشكل عام، فإن الأمريكيين هم الذين يحولون الضغوط إلينا حتى في هذه الأيام.
جنين عادت قبل سنة لتكون مدينة “الإرهاب”، كون إسرائيل استجابت لطلب أمريكي للامتناع عن اقتحامات للجيش الإسرائيلي للمدينة على مدى بضعة أشهر. تلك المهلة في “قص عشب الإرهاب” تعربد الأعشاب فيها دون تحكم – والدليل محاولات إطلاق الصواريخ من المنطقة نحو “جلبوع” وموجة العمليات التي بدأت فيها وتدحرجت حتى جبل الخليل وتل أبيب.
الخطر: حماستان في الضفة
وأخيراً، العامل الاقتصادي. الإسرائيليون لا يعرفون، لكن أموال ضرائبهم تبقي السلطة الفلسطينية على قيد الحياة بقدر كبير. للسلطة الفلسطينية ديون هائلة للكهرباء والمياه التي توردها إسرائيل لها، والتي لا يسددونها منذ سنين. “خدعة الحاويات” التي كشفت النقاب عنها “إسرائيل اليوم”، بينت أنه في كل سنة تحول مئات ملايين الشواكل التي يفترض بها أن تدخل إلى صندوق الدولة إلى السلطة الفلسطينية بسبب مخادعات المستوردين الفلسطينيين. لجنة شكلها سموتريتش تفحص منذ أشهر الموضوع الذي حذر منه مراقب الدولة في 2020، لكن لا أحد يسارع لسد ثغرة التسريب.
إسرائيل بالطبع تحول إلى السلطة أموال الضرائب التي تجبيها عنها، كما تعهدت في اتفاقات باريس. لنفترض أن هذا على ما يرام. لكن عملياً، إسرائيل لا تقتطع مخصصات أموال الإرهاب، رغم أن القانون الذي أقرته الكنيست يستوجب ذلك.
بمعنى أن الكابينت يعلن رسمياً عن اقتطاع المبالغ، لكن عندها تجري مناورات مالية مثل “القروض”، و”تأجيل التسديد”، و”سلفة دفعات على الحساب”، والتي تشطب الاقتطاع عملياً. حتى تلك الـ 600 مليون شيكل في السنة، تسمح لأبو مازن أن يبقي اقتصاداً فوق الماء.
ما لا يعرفه الإسرائيليون أيضاً هو أن وجود العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية يعرض الدولة وممثليها لخطر قضائي. فكون السلطة تدفع مخصصات “الإرهاب”، ولما كانت كياناً فاسداً حسب جهات دولية عديدة، فإنها تعتبر جسماً مبيضاً للمال.
السلطة الأمريكية لمكافحة تبييض الأموال التي يحذر كل العالم منها كفيلة أن تحدد كل من له علاقة مالية مع السلطة الفلسطينية كمشبوه بتبييض الأموال واتهامه في المحاكم الأمريكية، بل واستهداف إسرائيل أيضاً. ثمة سوابق لمثل هذا التصنيف من الأمريكيين. لهذا السبب، “ديسكونت” و”هبوعليم” – البنكان اللذان يحول المال عبرهما من الدولة إلى السلطة الفلسطينية- يطالبان منذ سنين بإعفائهما من هذه المهمة الخطيرة. وقد أقامت الحكومة لهذا الغرض قبل خمس سنوات “شركة خدمات التواصل”، لكنها لا تؤدي مهامها بعد.
في السطر الأخير للميزان، إلى جانب المنفعة التي تعطيها اتفاقيات أوسلو لإسرائيل، فإنها تلحق بها أضراراً جسيمة أيضاً. نبقي على كيان يساعد في قتل اليهود ويمنعه أيضاً، يلحق بنا أضراراً دولية لكنه يخفف منها أيضاً، يوفر لنا أموالاً لكنه يحلبنا اقتصاديا أيضاً.
هل سطر الربح إيجابي أم سلبي؟ منوط بعين الناظر. المؤكد أننا الآن في دائرة مغلقة لا يمكن لأي زعيم إسرائيلي أن يكسرها. كل محاولة إسرائيلية لإسقاط السلطة، وبالتأكيد من قبل الحكومة الحالية، سيرد عليه بعقوبات أمريكية صعبة الاحتمال. وعليه، فرغم الأثمان العالية من استمرار عمل السلطة الفلسطينية، لا أحد في إسرائيل يفكر بإسقاطها بجدية.
حتى سموتريتش الذي يعرّف السلطة الفلسطينية بأنها كيان إرهاب، يعرف أن خطته لبسط سيادة إسرائيل على عموم “المناطق” [الضفة الغربية] ليست قابلة للتنفيذ في المناخ الحالي في البلاد أو في الساحة الدولية. وعليه، قبل بموقف رئيس الوزراء في ذاك الجدال مع نتنياهو وليس فقط فيه.
نتنياهو أيضاً، الذي يدافع عن السلطة الفلسطينية في كل سنواته، حرص على ألا تنهار، ببساطة، يعتقد أنه لا بديل آخر. التحليل الذي عرض عليه وعلى الوزراء بجلسة الكابينت إياها، أظهر أنه لا جسم يقف على أهبة الاستعداد في هذا الوقت قد يمسك بالخيوط بدلاً من أبو مازن إلا حماس.
بمعنى أنه إذا لم يكن يكفينا حماستان واحدة في غزة – نتيجة مريرة جدا أخرى لاتفاقات أوسلو – فسنحصل على أخرى في الضفة. أمام سيناريو كابوس كهذا، واضح أن أهون الشرور، أي السلطة الفلسطينية، أفضل. لهذا السبب، حتى كابينت بن غفير وسموتريتش قرر قبل شهرين “أن تعمل إسرائيل على منع انهيار السلطة الفلسطينية”، بمعنى أن الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل هي الأخرى تواصل حماية السلطة الفلسطينية بألف مناورة ومناورة.
اليوم التالي
هل حكم علينا العيش مع هذه الثنائية الرهيبة إلى الأبد؟ بعد 30 سنة من أوسلو، باتت احتمالات انهيار السلطة الفلسطينية أكبر من أي وقت مضى في هذه الأيام. أبو مازن يقترب من سن 90، حكمه ضعيف، والتأييد له في أسفل الدرك. اليوم الذي يودع فيه العالم هو اليوم الذي ستحاول فيه حماس السيطرة على السلطة الفلسطينية، وليس فقط حماس. وعليه، ففي قرار الكابينت إياه الذي اقتبسناه آنفاً، كانت بضع كلمات أخرى. فالقرار آنف الذكر للعمل “لمنع انهيار السلطة الفلسطينية” اشترط بـ “عدم تغيير التقدير الوطني”. بمعنى، إذا ما وصلنا إلى التطورات القاسية آنفة الذكر، ربما يتغير التقدير الوطني ولا تعود إسرائيل لتعمل على إنقاذ حكم السلطة الفلسطينية. الاحتمال متدن، لكنه قائم.
ماذا سيأتي في مكانها؟ سطحياً، لن تتدخل إسرائيل في صراعات القوى الداخلية بين الفلسطينيين، بل ستركز على حماية مواطنيها. ومع ذلك، وبالأخذ بالحسبان أن إسرائيل هي رب البيت في المنطقة، فإنه إذا ما تطرف الوضع، فليس مؤكداً أن نتمكن من الوقوف جانباً. ماذا سنفعل؟ إذا وجدت خطط رسمية، فهي مخبأة في الجارور.
لكن ثمة من يطرح أفكاراً كفيلة بأن تشكل خشبة إنقاذ، من خارج المنظومة الحكومية. الأكثر معقولية هي “خطة الإمارات” التي تعمل عليها حركة “الأمنيين” على أساس اقتراح المستشرق د. مردخاي كيدار. تقول الخطة بإيجاز، إنه بدلاً من الاعتماد على كيان فلسطيني واحد، تقام سبع مدن دولة محلية.
نواة ستكون سيطرتها على أساس عشائر محلية، حسب التقاليد العربية. كل إمارة تحرص على أمنها وأمن إسرائيل. مجلس مشترك ينسق القرارات ذات الصلة بينها. المنفعة الأساس لمثل هذا المبنى هو استبدال العنصر الوطني بآخر عائلي – قبلي.
خطة “الأمنيين” ليست بالضرورة الصحيحة والأفضل، لكنها مثال على التفكير من خارج الصندوق. حان الوقت لتبدأ إسرائيل بفحص اقتراحات من هذا القبيل بجدية. 30 سنة على اتفاقات أوسلو، والأضرار الجسيمة إلى جانبها، فإن إعداد البدائل لا يمكن أن يضر.